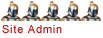منتدى علمي ثقافي تربوي ديني رياضي ترفيهي |
      |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شاطر |
 الثلاثاء 10 نوفمبر - 14:16 الثلاثاء 10 نوفمبر - 14:16 | المشاركة رقم: # | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  موضوع: حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي موضوع: حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي  حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي (1) حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي (2) حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي (3) حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي (4) حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي (5) الباب الثاني الحقوق الناشئة عن عقد الزواج تمهيد: إذا تمَّ عقد الزواج صحيحًا أنتج كلَّ آثاره، ومن هذه الآثار الحقوقُ الزوجية الناشئة عنه، وهذه الحقوق أنواعٌ ثلاثة: حقوق للزوج، وحقوق للزوجة، وحقوق مشتركة بينهما، وسوف نتناول كلَّ نوع من هذه الحقوقِ في فصل خاص على التوالي فيما يأتي. الفصل الأول: في حقوق الزوج: 1 - حق الطاعة. 2 - القرار في بيت الزوجية. 3 - القوامة والتوجيه. إنَّ حقوق الزوج على زوجته أعظمُ من أن تحيط بها امرأةٌ في العصر الحديث، إلاَّ مَن وفَّقها الله أعظمَ توفيقٍ إلى رضوانه وحسن مَغفرته، فقد رُوي - ما معناه - أنَّ امرأةً جاءت إلى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقالت: إنِّي مرسَلة من النساء إليك، وما منهن إلا وتهوى مخرجي إليك - وهن يقلن: إن الله ربُّ الرجال والنساء وإلهُهن، وإنَّك رسول الله إلى الرجال والنساء، وقد كَتَبَ الله الجهادَ على الرِّجال، فإن أصابوا أثروا، وإن استشهدوا كانوا أحياء عند ربهم يُرزقون، فما يعدل ذلك من أعمال النساء من الطاعة؟ فقال لها الرسول - عليه الصلاة والسلام -: ((طاعةُ أزواجهن، والمعرفة بحقوقهم، وقليلٌ منكن من تفعله)). وحقوق الزوج على زوجته كثيرةٌ، يُمكن تلخيص أهمها في الحقوق الثلاثة الآتية: حق الطاعة، والقرار في بيت الزوجية، والقوامة والتَّوجيه. الحق الأول: الطاعة: أوجب الله - تبارك وتعالى - على المرأة أن تطيع زوجها طاعةً مطْلَقة في غير معصية الله. أمَّا الطاعة، فيُقصد بها موافقتها إياه باستجابتها لطلبه وتلبية رَغباته، وقد أشار الله - سبحانه - إلى ذلك بقوله - عزَّ وجلَّ -: ﴿ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ﴾ [النساء: 34]، بمعنى أنَّ المرأة القانتة هي التي تطيع ربَّها، وتطيع زوجها، وتحفظه في نفسها وعفَّتها، وفي ماله وولده، في حضوره، وهي في غيبته أحفظ - مثل هذه يقال لها: صالحة، أو قانتة، أو مطيعة. وقد وردتْ في تعظيم هذا الحق أحاديثُ كثيرةٌ، منها - فضلاً عما تقدم -: قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أيما امرأة ماتتْ وزوجُها عنها راضٍ دخلتِ الجنة))، وقوله - عليه الصلاة والسلام -: ((والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حقَّ ربها حتى تؤدي حق زوجها...). وحق الرجل في طاعة زوجته له إنَّما هو في كلِّ ما يتعلق بحياتهما الزوجيَّة، أما بالنسبة لأموال الزوجة، فليس للزوج حقُّ التدخل في الشؤون المالية لزوجته، فهي صاحبة التصرف في أموالها ما دامتْ بالغةً رشيدة؛ أي: تتمتع بأهلية الأداء الكاملة. الحق الثاني: القرار في بيت الزوجية: الحق الثاني من الحقوق الثابتة للزوجِ على زوجته بمقتضى عقد الزواج: أنْ تَقَرَّ في بيته، الذي أعدَّه الزوج ليكون سكنًا لهما، ومستقرًّا لحياتهما الزوجية، تُشرف الزوجةُ عليه من حيث النظافة والترتيب والتنظيم، ويقوم الزوج بالإنفاق، وبكلِّ ما يتصل بذلك من متطلبات. وإذا كان قرارُ الزوجة في بيت الزوج حقًّا من حقوقه، فلا تخرج من بيته إلاَّ بإذنه، فإنَّ قرارَ المرأة في بيتها على العموم هو الحكمُ الشَّرعي العام في كلِّ امرأة مُتزوجة أو غير متزوجة، فلا تخرج من بيتها إلا لضرورةٍ تدْعو إلى هذا الخروج؛ يقول الله - تعالى -: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ﴾ [الأحزاب: 33]. فهذا النص الكريم، وإن جاء في صورته الظاهرة يخاطب نساءَ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فإنه ليس خاصًّا بهنَّ في الحكم؛ بل هو حكمٌ عام يُخاطب جميع المؤمنات، يقول العلاَّمة القرطبي: "وإن كان الخطاب لنساء النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقد دخل غيرُهنَّ فيه بالمعنى، هذا ولو لم يَرِدْ دليلٌ يخص جميعَ النساء، كيف والشريعة طافحةٌ بلزوم النساء بيوتهن، والانكفاف عن الخروج إلاَّ لضرورة؟". فالبيت هو مثابة المرأة التي تَجد فيها نفسها على حقيقتها كما أرادها الله، غير مشوهة ولا منحرفة ولا ملوثة، ولا مكدودة في غير وظيفتها التي هيَّأها الله لها بالفطرة... ولكي يُهيئ الإسلام للبيت جوَّه، ويهيئ للفراخ الناشئة فيه رعايتها؛ أوجب على الرجُل النفقة، وجعلها فريضة؛ كي يتاح للأمِّ من الجهد، ومن الوقت، ومن هدوء البال ما تشرف به على هذه الفراخ الزغب، وما تهيِّئ به للمثابة نظامها وعطرها وبشاشتها، فالأمُّ المكدودة بالعمل للكسب، المرهقة بمقتضيات هذا العمل، المقيَّدة بمواعيده، المستغرقة الطاقة فيه - الأم التي هذه حالها، لا يمكن أن تَهَب للبيت جوَّه وعطره، ولا يُمكن أن تمنح الطفولة النابتة فيه حقَّها ورعايتها... فحقيقة البيت لا توجد إلا بوجود امرأة، وأَرَجُ البيت لا يفوح إلاَّ أن تطلقه زوجة، وحنان البيت لا يتوافر إلا أن تتولاَّه أم، والمرأة أو الزوجة أو الأم التي تقضي وقتها وجهدها وطاقتها الروحية في العمل، لن تشيع في جوِّ البيت إلا الإرهاقَ والكلال والملال". غير أنه إذا وُجد المسوغ الشرعي لخروجها؛ مثل زيارة والديها، فهذا أمرٌ جائز، وقد ذكر بعض الفقهاء أنَّ لها أن تزور والديها كلَّ جمعة مرة، وأن تزور مَحارمها كلَّ عام مرة، وإذا مرض أحد والديها، وليس له من يقوم بتمريضه، وجب عليها الخروجُ لذلك، وحرُم على الزوج منعُها من أداء هذا الواجب، حتى ولو كان والدها غيرَ مسلم. فإذا خرجت بسبب مشروع، "فعليها أن تخرج مستترة متحجبة، تسير في المواضع الخالية، دون الشوارع والأسواق، مُحترزة عن أن يسمعَ غريبٌ صوتَها أو يعرِفها بشخصها، لا تتعرف إلى صديق بعلها في حاجاتِها؛ بل تتنكَّر على من يظن أنه يعرفها أو تعرفه"، ويحرم عليها أن تخرج متزينة، أو أن تُظهِر شيئًا من مفاتنها، فإذا كان وجهها يثير الفتنة، وجب عليها أن تستره بإجماع الفقهاء. ومما يتصل بهذا الحق - أو بهذين الحقين -: قيامُ الزوجة على شؤون البيت ورعايته، وتربية الأولاد، وما يتَّصل بذلك من أعمال، فقد روى البخاري - رحمه الله - بسنده عن علي - رضي الله عنه - أنَّ فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين - رضي الله عنها - ذهبت إلى أبيها سيد المرسلين - صلَّى الله عليه وسلَّم - تشكو إليه ما تلقَى في يدها من الرَّحَى، وتطلب رقيقًا أو خادمًا يقوم بهذا الأمر، كما روى أنَّ أسماء بنت أبي بكر الصدِّيق - رضي الله عنهما - كانت تقوم بكلِّ ما يحتاج إليه بيتُها من خدمات. وهكذا سائر نساء الصحابة - رضي الله عنهم جميعًا. غير أنه إذا كان الزوج قادرًا على الإتيان بخادمٍ أو أكثر، وكانت الزوجة من بيئة لا يعمل نساؤها، كان على الزوج أن يأتي بمن يخدم زوجته، ويُعينها على أداءِ واجبها في البيت إن كان ذلك ممكنًا. الحق الثالث: حق القوامة والتوجيه: الأصل في القوامة والتوجيه قول الله - تعالى -: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾ [النساء: 34]. بل إنَّ هذه الآية الكريمةَ هي الأصل في كلِّ حقوق الرجل على زوجته، فالله - عزَّ وجلَّ - جعله قوامًا عليها؛ بمعنى أنَّه يقوم على أمرها، كما يقوم الوالي على رعيته بالأمر والنهي والتوجيه والتأديب. وقد دلَّت الآية على أنَّ الزوجة الطائعة لا سبيلَ للزوج عليها؛ بل يُحسن عِشرتها، ويعاملها بالمعروف، ويقوم بأداء جميع حقوقها، ﴿ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ﴾ [النساء: 34]. أما الزوجةُ غير الطائعة، فقد نصَّت الآية على طريقة إصلاحها، ففي مرحلة الشروع في المخالفة، قبل أن تصير ناشزًا بالفعل، أرشد بتوجيهها إلى الطريقِ المستقيم، وذلك في قوله - سبحانه -: ﴿ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ﴾ [النساء: 34]، بمعنى أنَّ اللاتي تخافون عصيانهن وتعاليهن عمَّا أوجب الله عليهن، فإنَّ علاجهن حينئذٍ هو ما بَيَّنه الله - تعالى - من الوعظ، فالهجر في المضاجع، ثم الضرب. وبالنظر إلى أن الله - عزَّ وجلَّ - قد أنزل شريعته لصالح الناس جميعًا في كل عصر وجيل، وفي كلِّ بيئة ومكان، وبالنظر إلى النساءِ واختلافِ طبائعهن، "ففيهن مَن تردُّها الكلمة عن غيِّها، ومنهن من لا يؤثِّر فيها الكلام، ولا يردُّها إلا الهجرُ والحرمان، ومنهن من لا يُفيد معها كلام ولا هجر؛ لشراسةٍ في خلقها، وعنادٍ في طبعها، فلا يردُّها إلا الضربُ - بالنظر إلى ذلك، فإننا ندرك سرَّ تنوُّع وسائل التهذيب في كتاب الله، الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، والذي خلق المرأة وهو الخبير بأسرارها، العليم بما يُهذبها إذا ما القوى بها الأمر عن العبادة المستقيمة". وفيما يلي نبذة مختصرة عن كل وسيلة من وسائل الإصلاح التي نصت عليها الآية الكريمة. الوسيلة الأولى: الوعظ: من النص القرآني المبارك يُمكن القول بأنَّ الموعظةَ الحسنة مرحلةٌ إصلاحية، تسبقُ النشوز الفعلي، والمخالفةَ الحقيقيَّة، فعندما يلاحظ الرجل أماراتِ النشوز ودلائلَه في تصرفات زوجته، وذلك مثل: خشونة تصرفاتِها، بعد أنْ كانت هينة لينة، أو عبوس وجهها، فعليه أنْ يعظها الموعظة الحسنة بأسلوبٍ هيِّن لين، فإن لم ينفع معها ذلك الأسلوب، فإنه يشتدُّ عليها في القول، فإنْ لم ينفع، كان له تعنيفها باللفظ الذي لا كذبَ فيه، ولا افتراء، ولا عصيان لأمر الله، والفرق - بطبيعة الحال - كبير: بين لفظ هين لين يسير، وبين لفظ جافٍ غليظ عنيف، والواجب في كل ذلك أنْ يكون في دائرة المشروعية؛ أي: بحيث لا يخرج في ألفاظِه عن حدود الله - تعالى. فإذا ما استمرتْ رغمًا عن ذلك في طريق المخالفة والعناد، فإنَّه يلجأ إلى الوسيلة التالية. الوسيلة الثانية: الهجر في المضاجع: يقصد بالهجر في المضاجع الابتعاد عنها، بأنْ يوليها ظهرَه إنْ كانا على سرير واحد، أو يبيت في الحجرة نفسها، ولكن على سرير آخر، أو في البيت نفسه، ولكن في حُجرة أخرى، هذا هو الهجر المشروع علاجًا وتأديبًا للمرأة المعاندة، التي لم يصلح معها الإرشادُ والتوجيه والنصح. وقد يقال: إنَّ هذه الوسيلة لا تصلح لكلِّ النساء، ولكن في الواقع إنَّه علاج من رب العالمين، وهو مقياس لدرجة تعلُّق المرأة بزوجها، وعلى حد تعبير العلامة القرطبي - رحمه الله -: "فإن الزوج إذا أعرض عن فراشها، فإنْ كانت مُحبة للزوج، فذلك يشقُّ عليها، فترجع للصلاح، وإنْ كانت مُبغضة فيظهر النشوز منها، فيتبين أنَّ النشوز من قِبَلِها"، وإذا ثبت ذلك قامت الحُجَّة عليها أمام الله، ولا تلومنَّ إلا نفسها. أما الهجر خارج البيت، فهو غيرُ مشروع، وقد جاء النص القرآني حاسمًا في هذا الأمر؛ حيث قال - سبحانه -: ﴿ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ﴾ [النساء: 34]، وتعبير "في المضاجع" يثبت أن الهجر يتعيَّن أن يكون في البيت، ولقد بيَّن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - هذا الحكم بيانًا صريحًا حينما قال: ((ولا تهجر إلاَّ في البيت)). فسبحان من أنزل هذه الأحكام وشرعها لعباده في كلِّ زمان ومكان، وكأنَّها تتحدث الآن في زمنٍ انتشر فيه الفِسق والفُجور، وعمَّت البلوى وازدادت الشُّرور، فتركُ الرجل لبيته في مثل هذه الظروف معناه أنْ يكون عُرضة للانحراف نحو الفَسَقَة أو أعوان الشياطين، فكانت الحكمة من ربِّ العالمين أن لا يكون الهجرُ إلا في البيت. هذا، وينبغي أن يكون الهجر بلا جفوة ولا غلظة؛ إذ يكفي هنا كونه هجرانًا، فلا يجوز أن تصحبه جفوة موحشة، كما يتعيَّن أن لا تزيد مُدته عن أربعة أشهر، وهي مدة الإيلاء؛ حيث لا يحلُّ له الهجرُ بعد ذلك، فإنْ لم تنفع تلك الوسيلة، فهذا بُرهان على أنَّها امرأة شرسة مشاكسة، لا تنفع معها إلاَّ وسيلة أخرى، فلنبحث عنها فيما يلي. .......... 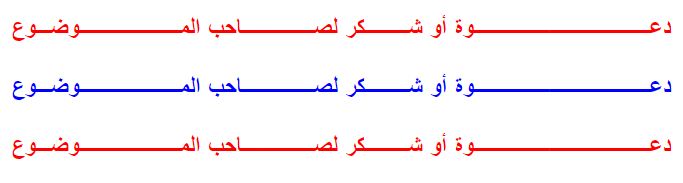  الموضوع الأصلي : حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: houdib69 
   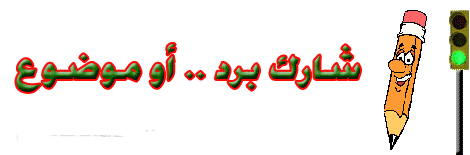
| ||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
 الثلاثاء 10 نوفمبر - 14:19 الثلاثاء 10 نوفمبر - 14:19 | المشاركة رقم: # | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  موضوع: رد: حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي موضوع: رد: حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي  حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي الوسيلة الثالثة: الضرب: أمَّا الضرب، فهو الوسيلة الأخيرة، فلا يلجأ إليها إلا عند عدمِ إفادة الوسيلتين السابقتين، والضرب المباح هو الضرب اليسير على حسب المقصود منه؛ إذ المقصد منه التأديب والتقويم، وهذا يحصل بالضرب اليسير. وينبغي ألاَّ يوالي الضرب في محل واحد، وأن يتَّقي الوجه؛ فإنَّه مجمع المحاسن، ولا يضرب بسوط ولا عصا، وأنْ يُراعي التخفيف في هذا التأديب على أبلغ الوجوه. ومع أنَّ الضربَ مباح، فقد اتفق العلماء على أن تركَه أفضلُ؛ لما ورد في الحديث الصحيح: ((ولن يضرب خياركم))، ولما رُوي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ولا تجدون أولئك خياركم))؛ بمعنى أنَّ الذين يضربون نساءهم ليسوا خيارَكم، فكان ذلك دليلاً من السنة صريحًا على أنَّ ترك الضرب أولى، وأنَّ ضربَ النساء ليس من شيم الخيار؛ ولذلك فإنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - لم يفعله قطُّ حتى مع خادمه، فما بالُك بزوجاته أمهات المؤمنين - رضي الله عنهنَّ - فقد أخرج النسائي عن عائشة، قالت: "ما ضربَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة ولا خادمًا قطُّ، ولا ضرب بيده شيئًا قط، إلا أن تنتهك محارم الله، فينتقم لله". تلك هي الحقوقُ الثلاثة الرئيسية، وتلخيص حقوق الزوج في هذه الثلاثة ليس معناه عدمَ وجود حقوق أخرى؛ بل يندرج ضمن حقِّ الطاعة، والقرار في البيت، والقوامةِ حقوقٌ فرعية كثيرة، كما أشرنا بالنسبة لحق الزوج في قيام الزوجة بخدمة البيت والإشراف عليه بصفة عامة، وبعد أنْ فصَّل الإمام الغزَّالي حقوقَ الزوج نراه يذكرها في عبارة مجملة؛ حيث يقول: "فحقوق الزوج على الزوجة كثيرة، أهمها أمران: أحدهما: الصيانة والستر، والآخر: ترك المطالبة بما وراء الحاجة، والتعفُّف عن كسبه إذا كان حرامًا، وهكذا كانت عادة النساء في السَّلف، كان الرجل إذا خرج من منزله تقول له امرأتُه أو ابنته: إيَّاك وكسْبَ الحرام؛ فإنَّا نصبر على الجوع والضر، ولا نصبر على النار... ومن الواجبات عليها كذلك - أي من حقوق الزوج عليها - ألاَّ تفرط في ماله؛ بل تحفظه عليه؛ قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا يحل لها أنْ تطعم من بيته إلاَّ بإذنه، إلا الرطب من الطَّعام الذي يُخاف فساده، فإن أطعمت عن رضاه، كان لها مثل أجره، وإنْ أطعمت بغير إذنه كان له الأجر، وعليها الوزر))". الفصل الثاني: في حقوق الزوجة: حقوق الزوجة كثيرة، منها حقوقٌ مالية، ومنها حقوق غير مالية، والحقوق المالية تَحتاج إلى شيء من التفصيل؛ لأهميتها العمليَّة في حياةِ الناس، وأمَّا الحقوق غير المالية، فيمكن تلخيصها وإيجاز القول فيها. ونتناول في هذا الفصل هذين النوعين من حقوق الزوجة في المبحثين الآتيين: المبحث الأول: في الحقوق المالية. المبحث الثاني: في الحقوق غير المالية. المبحث الأول: في الحقوق المالية: 1 - الصداق. 2 - النفقة. الحقوق المالية للزوجة منها ما تستحقُّه بمقتضى عَقدِ الزواج الصحيح، ومنها ما لا يَجب لها، إلاَّ بعد أن تستقر في بيت الزوجية. والنوع الأول من هذه الحقوق هو الصَّداق أو المهر، والنوع الثاني هو النفقة. وفيما يلي تفصيل القول عن هذين الحقَّين في مطلبين متواليين على النحو التالي: المطلب الأول: في الصداق: نبدأ كلامنا عن الصَّداق ببيان معناه، ثم نتكلم بعد ذلك عن حُكمه وطبيعته، ومن ناحية أخرى، فإن للصداق أنواعًا مُختلفة لا بُدَّ من بيانها، وهنالك بعض حالات يتأكد فيها، وبعض أمور قد يتأثَّر بها. وعلى ذلك؛ فإننا نقسم البحث عن الصداق إلى الفروع الثلاثة الآتية: الفرع الأول: في حقيقة الصداق وحكمه وطبيعته. الفرع الثاني: مقدار الصداق وأنواعه. الفرع الثالث: مؤكدات الصداق وما يؤثِّر فيه. الفرع الأول: في حقيقة الصداق وحكمه وطبيعته: أولاً: حقيقة الصداق: الصَّداق هو المال الذي يدفعه الزوجُ حقًّا للمرأة بمقتضى عقد الزواج. وهذا المال يُسمَّى صداقًا، ويسمى مهرًا، ويسمى فريضة، ولعلَّ كلمة (مهر) أكثر شهرة على ألسنة الناس، وأكثر تواردًا في عبارات الفقهاء. ولكنني آثرت - مع ذلك - كلمةَ صداق؛ لأسبابٍ، أولها: ورودُها في القرآن الكريم، فبخصوصِ تقرير هذا الواجب على الأزواج يقول الله - تعالى -: ﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ﴾ [النساء: 4]، وصَدُقات جمع صَدَاق، وثانيها: لأنَّ هذه التسمية تحمل معنى جميلاً أشار إليه بعضُ العلماء، هو أنَّ هذا اللفظ مأخوذ من الصِّدق؛ لإشعارِ الزوجة بصدق رغبة الزوج فيها، وثالث هذه الأسباب: أنَّ معظم الأحاديث الواردة في هذا الموضوع تعبِّر عن الحق المالي الثابت للمرأة هنا بكلمة "صَدَاق"، وهنالك أسماء كثيرة أخرى لهذا الحق غير ما ذكرنا. ثانيًا: حكم الصداق: الصداق واجب أكيد على عاتق الزوج، أوجبه الله - تبارك وتعالى - بنصوصٍ كثيرة في القرآن الكريم، منها: قولُ الله - تعالى -: ﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ﴾ [النساء: 4]، وقوله - سبحانه -:﴿ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ ﴾ [الأحزاب: 50]، وقوله - عزَّ وجلَّ -: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: 24]. وقد كان النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - لا يُقر زواجًا إلاَّ بصَداق؛ تنفيذًا لأمر الله - تعالى - وقد نُقِلتْ هذه السنة العملية نقلاً متواترًا؛ أي: ثابتًا ثبوتًا يقينيًّا لا شكَّ فيه، وقد أجمع المسلمون في كل العصور على وجوب الصَّداق في الزواج وفرضيته، وفي تفسير قوله - تعالى -: ﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ﴾ يقول العلامة القرطبي - رحمه الله -: "هذه الآية تدُلُّ على وجوب الصداق، وهو مجمع عليه، لا خلاف فيه". ثالثًا: طبيعة الصداق: الصداق أو المهر حقٌّ مالي ثابت للمرأة - كما أشرنا - وهو واجب فَرَضَه الله على الأزواج، سواء ذُكر في العقد أو لم يذكر؛ لأن الصداق ليس ركنًا من أركان عقد الزواج، ولا شرطًا من شروط صحته؛ بل إنَّ الزواج يصح من دون ذِكر صداق أو مهر، وقد دَلَّ على ذلك قول الله - تعالى -: ﴿ لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: 236]. فالآيةُ الكريمة تفترض انعقادَ الزواج من دون أن يفرض للزوجة فريضة؛ أي: من دون تسمية صداق أو ذكر مهر، وقد روى علقمة عن ابن مسعود أنَّه سُئِل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقًا، ولم يدخل بها حتى مات، فقال عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه -: لها مثل صداقِ نسائها، لا وَكْسَ ولا شَطَط، وعليها العدة ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - في بروع بنت واشق - امرأة منَّا - مثل ما قضيتَ، ففرح بها ابن مسعود. ومع أنَّ الصداق واجبٌ مفروض على الزوج، والعقد يصح من دونه، إلاَّ أنه أثرٌ من آثار عقد الزواج، فلولاه ما وجب شيء. وقد فرض الله هذا المالَ على الأزواج منحةً وعطية للزوجات، وهذا معنى قوله - تعالى -: ﴿ نِحْلَةً ﴾؛ أي: إنَّ الصداق عطية ومنحة من الله - تعالى - للمرأة؛ لأنه - سبحانه - أوجبه على الرجل من دون أن يفرض على المرأة شيئًا في نظيره، ولو تحققنا في الأمر، لرأينا أنَّ ما يعود على الرجل من الزواج، يعود على المرأة ما يُماثله؛ بل قد تكون المرأة أكثر استفادة بالزواج من الرجل، ولكن بالرَّغم من كل ذلك، فإنَّ فرض الصداق على الرجل وحدَه لا يخلو من حكمة تشريعية، فعقد الزواج شُرِعَ لمقاصدَ أخرى غير التمتُّع المشترك بين الزوجين، وهذه المقاصد لا توجد إلا بدوام العقد، والشارع جعل للزوج القوامة، وملَّكه الطَّلاق عند اشتداد النِّزاع، الذي لا تخلو منه الحياة الزوجية عادة، فلو شرع الزواج من دون مال يدفعه، لهانتْ عليه الزوجة، وتخلَّص منها لأتفه الأسباب؛ حيث أخذها بلا شيء، فكان وجوبُ الصداق عليه من عوامل حرصه عليها، وعدم التفريط فيها، فوق أنه يشعرها من أول الأمر أنَّها محل رعايته وتكريمه، وأنه سيتحمل عنها تكاليف الحياة، فتُقبل على الحياة الزوجية وهي راضية مطمئنة". ومتى كان الصداق حقًّا للمرأة، فإنَّه يجوز لها أن تُبْرِئ الزوجَ منه إنْ كان دينًا؛ أي: أنْ تتبرع له به أو بشيء منه، متى كانت بالغة رشيدة، وتوافرت بقية شروط التبرع، والأصل في ذلك قول الله - تعالى -: ﴿ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴾ [النساء: 4]. والقاعدة أنَّ الصداق يَصِحُّ بكل مالٍ متقوم معلوم علمًا نافيًا للجهالة، فهو يصحُّ إذا كان مبلغًا من النقود، أو مقدارًا من الذهب أو الفضة، أو عينًا معينة مثل: سيارة، أو قطعة أرض، أو منزل؛ بل يصحُّ أن يكون منفعة تقدر بالأموال، مثل: زراعة الأرض، أو سكنى المنزل، أو ما شابه ذلك. الفرع الثاني: في مقدار الصداق وأنواعه: 1 - القاعدة الأساسية. 2 - ليس له حد أقصى. 3 - الخلاف حول الحد الأدنى. 4 - الصداق المسمى. 5 - صداق المثل. 6 - الصداق المعجَّل والمؤجل. أولاً: مقدار الصداق: القاعدة الأساسية في مقدار الصَّداق هي في قول النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((خيرُ الصداق أيسره))، وقوله - عليه الصلاة والسلام -: ((أخفُّ النساء صداقًا أعظمُهن بركة)). وعلى ذلك؛ فإن الشريعة ترغِّب في التيسير على الناس في هذا الشأن، وأيُّ مغالاة في المهور تُعَدُّ خلاف سنة رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - التي رغبتْ في الصداق اليسير. ليس للصداق حد أقصى: أجمع فُقهاء الشريعة على أنه ليس للصداق حدٌّ أقصى يجب الالتزامُ به، وعدم الزيادة عليه. ولهذا - في نظرنا - حكمة بالغة، ترجع إلى أنَّ الحياة في تطورها لا تتوقف، فما يصلح الآن قد لا يصلح غدًا، وما كان بالأمس صالِحًا لا يُعَدُّ اليوم مقبولاً، فما بالنا باختلاف القرون الطوال، وتشريعٍ أنزله ربُّ العالمين لا يُعقل في نطاقه حصرُ العباد في إطارٍ مَحدود لا يصح لهم تجاوزه في هذا الشأن[45]؟ فما بالك بأمرٍ يبلغ الدرجةَ القُصوى من الأهمية، يتعلَّق بحياة الزوجين، وخاصَّة تلك الفتاة التي تحلم بحياةٍ جديدة، ومستقبل جديد، ومنهج للحياة جديد؟ ومن ناحية أخرى، فإنَّ ما يصلُح لفتاة معيَّنة قد لا يصلُح للأخرى، ولو كانتا في زمن واحد. ولعلَّ هذه الحكمةَ هي التي من أجلها شاءت إرادةُ الله - تعالى - أنْ تقف امرأةٌ أمام عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وتُعارضه في أمرٍ كان يريد إنفاذه، ويبدو أنه كان يريد وضعَ حدٍّ للمغالاة في المهور، وسواء أراد أن يحمل الناس على الالتزام بهذا الحد، أم أنه كان يريد مجرد النصح والتوجيه والإرشاد، فإنَّ الثابت عن الفاروق عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنَّه قال: "لا تغالوا في مهر النساء"، فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمر؛ إنَّ الله - تعالى - يقول: ﴿ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا ﴾ [النساء: 20]، فقال: أصابت امرأة وأخطأ عمر، وفي بعض الروايات: كلُّ الناس فقيه إلاَّ عمر. ولكن هل للصداق حدٌّ أدنى؟ وأمَّا عن الحد الأدنى، فقد اختلف الفقهاء حوله، فذهب الشافعي وأحمد إلى أنَّه يصح بأي شيء له قيمة مالية مهما كان قليلاً، ورُوي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وابن عباس، والحسن البصري، وابن المسيب، وربيعة، والأوزاعي، والثوري. وقد استدلوا بأحاديثَ كثيرةٍ، منها ما روي عن سهل بن سعد أنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - جاءتْه امرأةٌ، فقالت: يا رسول الله، إنِّي وهبت نفسي لك، فقامت قيامًا طويلاً، فقام رجلٌ، فقال: يا رسول الله، زوِّجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((هل عندك من شيء تصدقها إياه؟))، فقال: ما عندي إلاَّ إزاري هذا، فقال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنْ أعطيتها إزازك جلست لا إزارَ لك، فالتمس شيئًا))، فقال: ما أجد شيئًا، فقال: ((التمس ولو خاتمًا من حديد)). فدلَّ هذا الحديث على أنَّ الصداقَ يصحُّ بأي شيء يُسمى مالاً مهما قلَّت قيمتُه، وذهب أبو حنيفة وأصحابه - وهو أيضًا مذهب الشيعة - إلى أنَّ أقل الصداق عشرة دراهم؛ لما روي عن علي - رضي الله عنه -: "لا يكون مهرًا أقلُّ من عشرة دراهم". رأيُنا في هذا الموضوع: وبأدنى تأمُّل يبدو لنا أن المذهب الأول هو الراجح؛ لأنه استدل بحديث صحيح متَّفق عليه، وأمَّا المذهب الثاني فقد وقف عند استدلاله بقولٍ منسوب إلى عليٍّ - رضي الله عنه - وإذا ثبتت صِحةُ الحديث، فلا مقالَ لأحدٍ بعد الله ورسوله، وهذا على فرض صحة الرواية عن علي، والواقع أنَّها غير صحيحة، فقد قال علماء الحديث: إنَّ نسبة هذه الرواية إلى عليٍّ فيها مقال؛ فلا يصح الاستدلال بها. والذي نراه - والله أعلم - أنَّ الصداق ليس له حد أدنى، وسبب ذلك - في نظرنا - أن الله - تبارك وتعالى - أراد أن يترك تقدير الصداق - سواء قلَّ أم كثر - إلى الزوجين، أو بعبارة أخرى: إلى أهل العروسين، حسب الاتِّفاق والتراضي، دون تدخُّل من الشارع الحكيم، بعد تقرير المبدأ، وهو أن يكون الصداقُ فرضًا لا بد منه، أما كم هو؟ فذلك مرجعه إلى التوافُق والتراضي. والله - تبارك وتعالى - قد أشار إلى هذا الحُكم بنصوص صريحة في الكتاب؛ حيث يقول - سبحانه -: ﴿ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: 24]. ...... 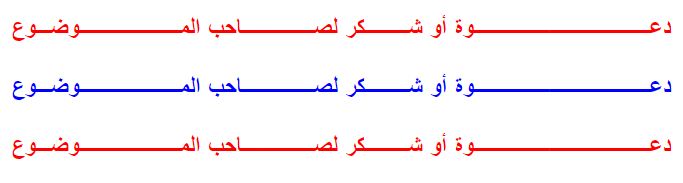  الموضوع الأصلي : حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: houdib69 
   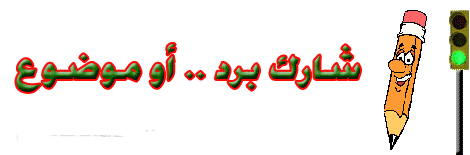
| ||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
 الثلاثاء 10 نوفمبر - 14:22 الثلاثاء 10 نوفمبر - 14:22 | المشاركة رقم: # | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  موضوع: رد: حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي موضوع: رد: حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي  حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي ثانيًا: أنواع الصداق: يتنوَّع الصداقُ تبعًا لاتِّفاق الطرفين على تسميةِ صداق مُعين، وقد لا يسمون شيئًا، وقد يتَّفق الطرفان على تعجيل بعض الصداق وتأجيل البعض الآخر. (أ) الصداق المسمى وصداق المثل: الصَّداقُ المسمَّى: هو الذي يتَّفق عليه الطرفان، بأن يُحددا مبلغًا من النقود، أو عينًا معينة، أو منفعة شيء، أو ما إلى ذلك من الأشياء التي تصلح أنْ تكون صداقًا. وأصلُ هذا النوع جاء من أنَّ الطرفين يُسمون الصداق؛ أي: يذكرونه ويُحددون مقداره أو قيمته أو كميته، فهو مُسمًّى؛ أي: منصوص عليه بالاسم والاتِّفاق عليه بين الطرفين، سواء كانت تسميتهم للصداق أثناء إبرام عقد الزواج، أم أنَّهم اتفقوا عليه بعد فترة لاحقة من إبرامهم العقد. ويشترط في كل الأحوال أنْ يكونَ عقد الزواج صحيحًا، وأنْ تكون التسمية صحيحة، فإذا كان الصداقُ المتفق عليه بين الزوجين أقلَّ من صداق المثل، كان للولي حقُّ الاعتراض على هذه التسمية، قبل إتمامِ الزواج كما سبق أن بيَّنا، ما لم يقبل الزوجُ رفعَ الصداق إلى الحد الذي يُماثل صداق أمثالها، ومن باب أولى لو كان الزواجُ غيرَ صحيح، فإن التسمية أيضًا تكون غير صحيحة؛ لأن الفساد أو البطلان يسري إلى العقد في جملته. صداق المثل: وأمَّا صداقُ المثل، فيُقصد به الصداق الذي يُدفع عند زواج أمثالها من بناتِ قومِها، مثل بنت عمها، أو بنت أخيها، أو ما يُدفع عادةً صداقًا لنظائرها من نساء أهلها، "وتكون المماثلةُ فيما يعتدُّ به من صفاتِ الزوجة التي يرغب فيها من أجلها؛ كالدِّين، والأدب، والعقل، والعلم، والجمال، والسن، والبكارة والثيوبة، وكونها ولودًا أو عقيمًا، والبلد الذي تعيش فيه، فإذا لم يوجد من قوم أبيها من يُماثلها، يعدُّ من يُماثلها من أسرةٍ تماثل أسرة أبيها من أهل بلدها". وفي كلِّ الحالات يتعيَّن النظرُ في تلك المماثلة إلى الزوج، فالمليء يَختلفُ التقديرُ معه بالنسبة إلى متوسط الحال، والرجل ذو المكانة الفاضلة قد يتسامح الناسُ معه في المسائل المالية، وهكذا. الحالات التي يجب فيها صداق المثل: 1 - إذا كان عَقد الزواج خاليًا من النص على الصداق، بأنْ أُبْرِمَ العقد من غير ذِكر صداقٍ معيَّن، فهنا يَجب صداق المثل. 2 - إذا نص العَقد صراحةً على نفي الصداق كليةً، بأن وجد بند في العقد ينص على أن الطرفين اتفقا على الزواج من دون صداق، فهذا الاتفاقُ لا أَثَرَ له في سقوط هذا الحق؛ لأنَّه وإنْ كان حقًّا ماليًّا ثابتًا للمرأة، إلاَّ أنَّه حق فرَضَه الله - تعالى - فالمرأة لها حقٌّ فيه، والوَلي له حق فيه، ولكنَّه أولاً وآخرًا هو من الحقوق التي لا يَجوز إسقاطها؛ لأن حق الله فيه غالبٌ، فبعد أن أمر الله - عزَّ وجلَّ - بأداء الصداق معبرًا عنه بالفريضة، قال - سبحانه -: ﴿ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ﴾ [النساء: 24]. 3 - إذا كانت تسميةُ الصداق غير صحيحة، بمعنى أنَّهم اتفقوا على صداق مُسمى فيما بينهم، ولكن هذا الذي اتَّفقوا عليه لا يصح أن يكون صداقًا، بأن كان غير متقوم، أو غير معلوم، أو شيئًا غائبًا مجهولَ الحقيقة، ففي كلِّ هذه الحالات وأمثالها يتعيَّن أن يكون لها صداق مثلها. زواج الشغار: ويدخل في هذه الصورةِ زواجٌ كان شائعًا في الجاهلية، يُسمُّونه زواج الشغار، وهو عبارةٌ عن زواج في نظير زواج، من دون مهر في الزواجَيْن، بمعنى أنَّ الرجل يزوِّج ابنته أو أخته في نظيرِ أنْ يتزوَّج هو ابنةَ الآخر أو أخته، من غير صداق في الحالين؛ لأنَّهم يعدون الصداق هنا هو المقابلة بين المرأتين، فصداق الأولى أن يزوِّجه الثانية، وصداق الثانية أن يزوِّجه الأولى، وقد نهى النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - عن هذا الزواج. وجمهور الفقهاء يقولون: إنَّ زواجَ الشغار باطل، حتى ولو سَمَّيَا صداقًا بعد ذلك، أمَّا الحنفية فقد قالوا: إنَّ الزواج فاسدٌ؛ ولكن هذا الفساد يزول إذا سَمَّيَا صداقًا، بل حتى لو لم يسميا شيئًا، فإن الزواج يصح بمهر المثل. ومنشأ الخلاف هو الحكمة من النَّهي، فالجمهور يقولون: إنَّ هذا النوع من الزواج قد نهى عنه رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وما كان كذلك فهو باطل، وأما الحنفية فيقولون: إنَّ النهيَ من أجل عدم التسمية وما فيها من إجحاف بالمرأة وظلمٍ لها، من حيث هضم حقها في الصداق، فإذا سَمَّيَا صداقًا بعد ذلك، فقد ارتفع الظلم وصحَّ الزواج. رأينا في هذا الخلاف: ولا شك لدينا في ترجيح مذهب الجمهور؛ لأنَّ كل فعلٍ جاء على خلاف حكم رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فهو باطل، كيف وقد قال الله - تعالى -: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور: 63]؟! وليستِ الحكمةُ من النهي ترجعُ إلى عدم التسمية، كما قال الحنفية؛ بل إنَّ النهي - في نظرنا - هو تكريمٌ للمرأةِ، ورفع لشأنها من أن تكون سلعةً في مقابلة سلعة، حتى ولو ذكر صداق بعد ذلك، فلا يزال الزواجُ باطلاً؛ حيث لا يليق بالمرأة التي هي شريكة حياة أنْ يتم زواجها بهذه الطريقة، في نظير عقدٍ آخر بين رجل آخر وامرأة أخرى! 4 - الحالة الرابعة من الحالات التي يجب فيها صداق المثل، هي ما إذا لم تثبت تسمية الصداق بالبينة، فإنَّه حينئذٍ يجب صداق المثل. فلو أن الزوجة ادَّعت أكثر من صداق المثل، وادَّعى الزوج أقل من ذلك، ولم يستطع أيٌّ من الطرفين أن يثبت تسمية ما ادَّعاه، فإن الواجب هنا هو صداق المثل، أما إذا ادَّعت المرأة أقل من صداق مثلها، حُكِم لها بما ادَّعته، وكذلك لو أن الزوج ادَّعى أكثر من صداق المثل، فإنه يحكم بما ادَّعى. 5 - إذا أبرم عقد زواج في مرض الموت وسمى صداقًا أكثر من صداق المثل، فإنَّها لا تستحق إلا صداق المثل، وما زاد على ذلك يأخذ حكم الوصية للوارث، فلا تصح شرعًا إلا بإجازة الورثة. الأقل من الصداق المسمى وصداق المثل: تكلَّمنا عن وجوب الصداق المسمى، وعن الحالات التي يجب فيها صداق المثل، وفي كل هذه الحالات، فإنَّ عقد الزواج عقدٌ صحيح؛ لذلك وَجَب فيها المسمى أو صداق المثل، على ما بَيَّنَّا. أما إذا كان عقد الزواج غيرَ صحيح، فهو عقد محرَّم شرعًا، ولا اعتبار له في نظر الشريعة؛ ولهذا فلا يَجب فيه شيء قبل الدخول. على أنَّ العقدَ غيرَ الصحيح قد يكون باطلاً، وقد يكون فاسدًا، فإذا ما حصل دخول بناء على العقد الفاسد، كمن تزوَّج أختَ مطلقته طلاقًا بائنًا قبل انتهاء العِدَّة، فإن هذا الدخولَ محرَّم شرعًا، يتحتم رفعه بالتفريق بينهما جبرًا، ولكن العقد هنا يُعَدُّ شبهة تدرأ الحد، والقاعدة أن الدخول لا بد فيه من حدٍّ أو صداق، فإمَّا أن يَجب للمرأة الأقل من الصَّداق المسمى أو صداق المثل، بمعنى أنَّه يَجب إعطاءُ المرأة الحد الأدنى: إمَّا صداق المثل إن كان هو الأقل، وإمَّا الصداق المسمى إنْ كان هو الأقل. الصداق المعجل والصداق المؤجل: الصَّداق المعجل والصداق المؤجل ليس من قبيل أنواع الصداق؛ وإنَّما هو مجرد تقسيم للصداق المتَّفق عليه؛ حيث جرى العُرف أن يكون الصداق مقسمًا بين معجل ومؤجل، أو ما يسمى مُقدمَ الصداق ومُؤخره، فيُدفع المقدم أولاً عند إبرام العقد أو بعده، وعادةً ما يكون قبل الدخول، أمَّا المؤخر فلا يدفع إلاَّ عند أقرب الأجلين: الطلاق، أو الوفاة. فإذا طلقت طلاقًا بائنًا، وجب على الرجل أنْ يدفعَ لها مؤخرَ صداقها، وإذا تُوفيت كان لورثتها أنْ يُطالبوا الزوج بمؤخر الصداق، ويكون هذا المؤخر عنصرًا من عناصر تركتها، أمَّا إذا توفي الزوج، فيكون من حق الزوجة أن تستوفي مؤخر صداقها من تركته قبل تقسيمها، باعتبار هذا المؤخر دَينًا ثابتًا في ذمته. وتقسيم الصداق إلى مقدم ومؤخرٍ مرجعُه - كما أشرنا - إلى العُرف الذي لا يخالف قاعدة شرعية، فهو لهذا السبب عُرف شرعي، ولما فيه من مصلحة، هي التيسير على العباد في عقود زواجهم. فإذا نصَّ عقد الزواج على الصداق، ولم يُذكَر فيه مقدمٌ ولا مؤخر، فقال بعض الفقهاء: يطبَّق العرف السائد في بلد الزوجَيْن وقتَ إبرام العقد. وذهب فريق آخر إلى أن الأصل في الصداق أنْ يكون معجَّلاً، فإذا لم يوجد نص خاص بالتأجيل، فإنه يجب على الزوج أو كفيله أن يدفعه بأكمله؛ لأنَّ الصداقَ حكمٌ من أحكام عقد الزواج، وهو عقد لا تتراخى أحكامُه عن أسبابه، فكان الواجب تعجيلَه بمجرد تمام العقد، ولكنه يؤخر بالشرط، ولا شرط؛ فيبقى الأصل". الفرع الثالث: في مؤكدات الصداق وما يؤثر فيه: نقصد بمؤكِّدات الصداق الأمورَ التي إذا حدثتْ أو حدث بعضها، أصبحَ الصداقُ حقًّا مؤكدًا للمرأة، لا يقبل التأثر بأيِّ أمرٍ آخر، فلا مَجال لسقوطه أو لإنقاصه بعد ذلك أبدًا. ونقصد بعبارة "ما يؤثر في الصداق": الأمور التي قد يترتب على وجود بعضها نقصٌ في المهر، أو زيادة فيه، أو ما إلى ذلك من المؤثرات. أولاً: مؤكدات الصداق: يتأكَّد الصداق بأمرين لا خلاف فيهما، وهما: الدُّخول، وموت أحد الزوجين، كما يتأكد الصداقُ بالخلوة الصحيحة عند بعض الفقهاء. (أ) الدخول: يُقصد بالدُّخول انتقالُ الزوجة إلى بيت زوجها، والدخول الذي يترتب عليه تأكيد الصَّداق هو الدخول الحقيقي؛ بحيث يطلع زوجها عليها، ويتصل بها جنسيًّا، وتأكيد الصداق في هذه الحالة؛ لأنه بالدخول الحقيقي تبدأ الحياة الزوجية مرحلةً تختلف عما كانت عليه من قبل، وتكون الزَّوجة قد قامت بواجبها؛ حيث مكَّنته من نفسها، فكان حقًّا أن يجب لها سائر حقوقها التي على الزوج وجوبًا مؤكَّدًا، وأولُها الصداق؛ حيث يصبح غير قابل للإسقاط أو الإنقاص. (ب) وفاة أحد الزوجين: إذا توفي أحد الزوجين قبل الدخول، فإنَّ الصداق المتفق عليه يتأكَّد وجوبُه ويتعين؛ حيث يصبح حقًّا ثابتًا للمرأة، غير قابل للإنقاص أو السقوط، وسبب ذلك أنَّه بِموت أحد الزوجين ينتفي كلُّ سبب قد يؤثِّر في الصَّداق، وبانتفاء الأسباب المؤثرة في الصداق يتحقَّق تأكيده من جميع الوجوه. فإذا كان الصداقُ منصوصًا عليه في العقد أوِ اتَّفقا على تسميته بعد ذلك، وَجَب الصداق المسمى بتمامه، وإذا لم تكن هنالك تسمية، بأنْ تُوُفي، ولم يُسمِّ له صداقًا، وجب صداقُ المثل؛ عملاً بقضاء رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - في بروع بنت واشق؛ حيث توفي زوجها قبل أن يدخل بها، فقضى لها النبيُّ - عليه الصلاة والسلام - بصداق مثلها. (ج) الخلوة الصحيحة: يُقصد بالخلوةِ أنْ يَجتمع الزوجان في مكانٍ يأمنان فيه من اطِّلاع الغير عليهما، هذا هو المقصود بالخلوة، ولكن هذه الخلوة لا تكون مؤكدة للصَّداق، إلاَّ إذا كانت خلوة صحيحة، وهي تكون كذلك إذا انتفتِ الموانع التي تَحول بين الرجل وبين الدخول الحقيقي بزوجته. وهذه الموانع إمَّا أن تكون موانعَ ماديةً، كما إذا كان بالمرأة عيبٌ يحول دون الزوج ودون دخوله بها دخولاً حقيقيًّا. وإمَّا أن تكون موانع شرعية، كما إذا كانت خلوتهما في نهارِ رمضان، أو كانا مُحْرِمين للحج، أو كانت الزَّوجةُ في مدة حيضها؛ حيث حرم الله على الرجال قربان زوجاتِهم في هذه الحالات الثلاث. وفقهاء المذهب الحنفي هم القائلون بأنَّ الخلوة الصحيحة هي التي يتأكد بها الصَّداق؛ حيث أعطوها حكم الدخول الحقيقي. وقد خالف المالكية والشافعية والإمامية في ذلك؛ حيث قالوا: إنَّ الخلوة - ولو كانت صحيحة - لا تؤكِّد الصداقَ، فإذا طلَّقها بعد الخلوة يَجب لها نصف الصداق - كما سيأتي. وأمَّا الحنابلة، فقد ذهبوا إلى أبعد مما ذهب إليه الحنفية؛ حيث قالوا: إنَّ الصداق يتأكد حتى من دون خلوة، فلو لمسها بشهوة أو قَبَّلها بشهوة، فإن هذا منه يؤكِّد لها صداقًا كاملاً. والمعمول به في مصر هو المذهب الحنفي. الدخول والخلوة الصحيحة: هذا، ويُقرر الحنفية أنَّ الخلوة الصحيحة تتَّفق مع الدخول الحقيقي في النتائج الآتية: 1 - تأكيد الصداق؛ أي: إنَّ كلاًّ من الخلوة الصحيحة والدُّخول الحقيقي يترتب عليه تأكيدُ الصداق للمرأة - على ما بينَّا. 2 - ثبوت النسب: يترتب على الخلوة الصحيحة ثبوتُ نَسَبِ الولد؛ لأنه من زوجة في عقد زواج صحيح، كما يترتب ذلك تمامًا على الدُّخول الحقيقي. 3 - وجوب العدة: تَجب العدة على المرأة إذا ما طلقتْ بعد الخلوة الصحيحة، كما هو الحال بالنسبة للمُطلقة بعد الدخول الحقيقي. 4 - وجوب النفقة: تَجب النفقة للمرأة التي اختلى بها زوجُها خلوة صحيحة، مثلها في ذلك مثل المرأة التي دخل بها زوجها دخولاً حقيقيًّا. 5 - حرمة التزوج بإحدى محارمها: يترتب على الخلوة الصحيحة أنه يحرُم على الرجل أن يتزوج بإحدى محارمها، ما دامتْ في عصمته، أو حتى بعد طلاقها إلى أن تنتهي عدتُها، كما هو الحكم بالنسبة للدخول الحقيقي. ومن ناحية أخرى، فإنه يحرُم على الرجل أن يتزوَّجَ بغيرها في مُدة العدة، إذا كان في عصمته ثلاثٌ غيرها. فالدخول الحقيقي والخلوة الصحيحةُ يتفقان في جميع هذه الأحكام. اختلاف الخلوة عن الدخول: أمَّا الأحكام التي تختلف الخلوة الصحيحةُ فيها عن الدُّخول الحقيقي، فإنَّها تتلخص فيما يأتي: 1 - الدخول الحقيقي يُحْصِنُ الزوجين، أمَّا الخلوة وإنْ كانت صحيحة فلا تحصنهما. 2 - الدخول الحقيقي يحرِّم فروع الزوجة، أمَّا الخلوةُ الصحيحة فلا تحرِّمهن؛ لأن الله - تعالى - يقول: ﴿ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ﴾ [النساء: 23]. 3 - بالدخول الحقيقي تَحِلُّ المطلقةُ ثلاثًا لزوجِها الأول، فيما لو طلَّقها الثاني طلاقًا طبيعيًّا، أمَّا الخلوة الصحيحة، فلا يترتب عليها هذا الحِلُّ. 4 - الطلاقُ بعد الخلوة الصَّحيحة يكون دائمًا طلاقًا بائنًا؛ لأنه طلاقٌ قبل الدُّخول، أما الطلاق بعد الدخول الحقيقي، فقد يكون طلاقًا رجعيًّا، وقد يكون بائنًا - حسب الأحوال. 5 - المطلقة رجعيًّا بعد الدخول الحقيقي، تتوارثُ مع زوجها إذا مات أحدُهما قبل انقضاء العِدَّة، ولا توارثَ بينهما في الطلاق البائن، إلاَّ إذا كان فارًّا من الميراث، أمَّا المطلقة بعد الخلوة، فلا ترث مُطلقًا؛ لأنَّ طلاقها بائن من يومِ صُدوره. 6 - المطلقة بعد الدخول الحقيقي تُعَدُّ ثيبًا، فتُزوَّج بعد ذلك زواجَ الثيبات، أمَّا المطلقة بعد الخلوة الصحيحة، فإنها تُعَدُّ بكرًا، وتُزوَّج بعد ذلك زواجَ الأبكار. إثبات الخلوة: إذا تصادق الزَّوجان على الخلوة الصحيحة، فلا إشكالَ؛ حيثُ يثبُت لها الصداق كاملاً، أما عند الإنكار، فعلى الزوجة إثباتُ الخلوة بالبيِّنة، فإنْ عجزت وجَّه القاضي اليمين إلى الزوج، فإن حلف على نَفي الخلوة، كان لها نصفُ المهر؛ لأنَّها تعدُّ مُطلقة قبل الدخول والخلوة. ثانيًا: ما يؤثر في الصداق: الأمورُ التي تؤثر في الصَّداق ترجِعُ في معظمها إلى إرادة الزوجين أو أحدهما، فقد يتفقان على زيادة الصَّداق، وهنالك بعضُ تصرفاتٍ قد تؤدي إلى سقوطه بتمامه. (أ) زيادةُ الصداق أو إنقاصه: إذا أراد الزوجُ أن يزيد في صداق زوجته الذي سَمَّاه من قبل، فهذا من حقه، وهو تبرع منه إليها، وما دام الزوجُ أهلاً للتبرعات المالية، فإنَّ هذا التصرُّف لا غبار عليه، إلا أنه يحتاج إلى قبول الزوجة أو وليِّها. ومن ناحية أخرى، فإنَّه يَجوز للزوجة أن تنقص من صداقها المسمَّى لها في العقد تسميةً صحيحة، مع مُراعاة حق الشارع، وحق الولي، أمَّا حق الشارع، فيتمثل في أنه لا يَجوز لها إلغاء الصداق أو التنازُل عنه بالكلية قبل قَبضه، وأمَّا حقُّ الولي، فيتمثَّل في أنَّها إذا أنقصت صداقَها إلى ما دون صداقِ المثل، فإنَّه يَحق للولي أنْ يعترض على هذا التصرف؛ بل على عقد الزواج - كما سبق أن أشرنا. وغَنِيٌّ عن البيان أنه يشترط في الزَّوجة في هذه الحالة أنْ تكون أهلاً للتبرُّع، فإذا أنقصتْ شيئًا من صداقها وكان الصداقُ من المثليات (المكيلات والموزونات والمعدودات)، فإنَّ تنازُلها عن جزء من صداقِها يُعد إبراءً للزوج، لا يَحتاج إلى قَبول؛ بل يكفي من الزوج عدمُ الرد - أي: عدم ردِّ هذا التنازل - أمَّا إذا كان الصداقُ عينًا معينة بالذات؛ مثل: المنزل، أو قطعة الأرض، أو السيارة، فإن تنازل الزوجة عن جزء منها يُعد هبةً من الزوجة، لا بُدَّ فيها من قبول الزوج، وإلاَّ لم يصح التنازل. (ب) سقوط نصف الصداق: إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول بها، وكان قد فرضَ لها صداقًا، فإنَّها تستحق نصف هذا الصداق، وهو حُكم منصوصٌ عليه صراحةً في الكتاب العزيز؛ يقول الله - تعالى -: ﴿ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [البقرة: 237]. وبصريح هذه الآية المباركة، فإنَّه في حالةِ فرض صَداقٍ معلوم لها، يكون من حَقِّها نصفُ الصداق المفروض إذا ما طُلِّقت قبل الدُّخول، هذه هي القاعدة، ولكنَّ القرآنَ الكريم يدَع الأمر بعد ذلك للمُسامحة والفضل واليُسر، فللزوجة أن تعفوَ أو لوليها أن يعفو، والتنازُل في هذه الحالة تنازل الإنسان الراضي القادر على العفو، السمْح الذي يعفو عن مال رجل قد انقصمت منه عُروته، ومع هذا فإن القرآن يلاحق هذه القلوب؛ كي تصفوَ وترقَّ وتخلو من كل شائبة: ﴿ وَلاَ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [البقرة: 237]. ويُشترط لكي تستحق المطلقة قبل الدخول نصف الصداق شروطٌ أربعة: الشرط الأول: أن يكون عقد الزواج صحيحًا. والشرط الثاني: أن يكون الصداقُ متفقًا عليه بين الطَّرفين، وعلى حد عبارة الفقهاء: أنْ يكونَ مسمًّى تسمية صحيحة. والشرط الثالث: أن يكون الطلاق أو الفسخ بسببٍ من قِبَلِ الزوج. والشرط الرابع: أن يكون الطلاقُ أو الفسخ قبل الدخول أو قبل الخلوة الصحيحة. إذا توافرتْ هذه الشروط الأربعة، وَجَبَ للمرأة نصفُ الصداق المسمَّى، وقد رأينا منذ قليل أنَّ الدخول الحقيقي يؤكد للمرأة صداقَها بأكمله، ورأينا كذلك أنَّ فقهاء المذهب الحنفي يعطون للخلوةِ الصحيحة حكمَ الدخول، فيتأكد بها الصداقُ كله للمرأة، وأنَّ الحنابلةَ يتوسعون في ذلك، فيقولون: إنَّ مُجرد اللمس بشهوةٍ يُؤكد للمرأة كلَّ صداقها، وعلى ذلك فالمقصودُ من شرط قبل الدخول: أن يكون الطلاق أو الفسخ قبل الدخول الحقيقي أو قبل الخلوة الصحيحة بسببٍ من جانب الزوج، فيدخل في ذلك الفرقة بسبب ارتدادِ الزوج عن الإسلام - والعياذ بالله تعالى - أو الفرقة بسبب امتناعِ الزوج غير المسلم عن الدُّخول في الإسلام إذا ما أسلمتْ زوجته، والفرقة بسبب اقتراف الزوج مع إحدى أصول زوجته أو إحدى فروعها ما يوجب حُرمة المصاهرة. على أنَّه إذا كان الفسخُ من جانبه بسببِ خيار البلوغ أو الإفاقة، فإنَّ ذلك لا يُوجب على الرجل شيئًا، بمعنى أنَّ المرأة لا تستحقُّ نصفَ الصداق في هذه الصورة - على ما سنُبينه في الفقرة التالية. سقوط الصداق بأكمله: يسقط الصداق بأكمله في الحالتين الآتيتين: الحالة الأولى: إذا كانت الفرقة بسبب استعمالِ الزوج حقَّه في خيار البلوغ أو الإفاقة، الذي سَبق أن أشرنا إليه عند كلامنا عن زواج الصِّغار ومن في حكمهم. الحالة الثانية: إذا كانت الفرقة قبل الدُّخول أو الخلوة، بسببٍ من قِبَل الزوجة، سواء كانت الفرقة بسببٍ مشروع؛ كما إذا كانت عديمةَ الأهلية أو ناقصتَها وزوَّجها غيرُ الأب والجد، فاستعملت حقَّ الخيار عند البلوغ أو الإفاقة، أو كانت الفرقة بسببٍ غير مشروع، كما إذا ارتدت عن الإسلام - أعاذنا الله من ذلك - وكما إذا أبت الزوجةُ المشركة أن تسلم أو أن تدخل في دينٍ سماوي بعد أنْ أسلم زوجها، أو كما إذا فعلتْ مع أصولِ زوجها أو فروعه ما يوجب حرمة المصاهرة. والحكمة من سقوط الصَّداق في هذه الحالة ترجعُ إلى أن الزوجةَ هي السبب في فراقها عن زوجها دون ذَنبٍ جناه، فكانت هي السببَ في ضياع حقوقها من هذا الزَّواج؛ فلا يجب لها شيء من الصداق. ........ 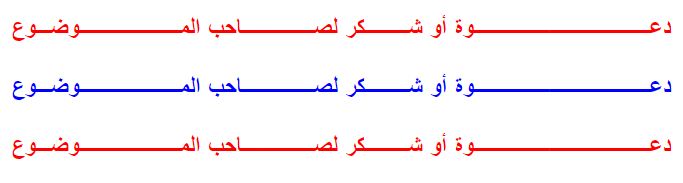  الموضوع الأصلي : حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: houdib69 
   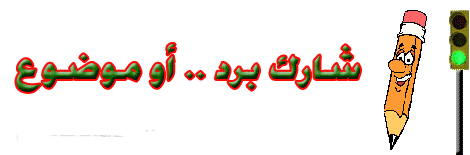
| ||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
 الثلاثاء 10 نوفمبر - 14:25 الثلاثاء 10 نوفمبر - 14:25 | المشاركة رقم: # | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  موضوع: رد: حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي موضوع: رد: حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي  حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي منازعات الزوجين حول الصداق: منازعات الزوجين حول الصَّداق، إمَّا أن تكون في أصل التسمية - أي: هل سبق الاتفاق على صداق أو لا؟ - وقد تكونُ المنازعة في مِقدار الصَّداق أو في قَبضه أو في وصفه. والواقعُ أن هذه المنازعات - كلها أو معظمها - كانت متصوَّرة في الصَّداق، أو في قبضه، أو في وصْفه. والواقع أنَّ هذه المنازعات - كلها أو مُعظمها - كانت متصورة في ظل القواعد الفقهية المجردة. أما الآن، فقد اشترط القانون لسماع دعوى الزوجية أمام القضاء أنْ يكون الزواجُ موثقًا أمام الموظف المختص، وفي الوثيقة الرسمية بندٌ خاص بالصداق، وهذا هو أصل التسمية، فلا مجالَ للخلاف حولها، وفي هذا البند الخاص بالصداق يبين مقداره، والمقدم منه والمؤخر، وبهذا ينتهي النزاع حول مقدار الصداق. قبض الصداق: والواقع أن قبض الصداق يَحول دون أي نزاعٍ حوله في المستقبل، وقد تقوم المرأة بقبض الصداق، فهو حقها ولها أنْ تقبضه إذا كانت بالغة رشيدة، ولكن جَرى العُرف على أن الولي هو الذي يقوم بقبض الصداق نيابةً عنها، وهو عرف شرعي؛ بل إنَّ وجودَ الولي أمرٌ جوهري في عقد الزواج - كما سبق أنْ بينَّا - وفضلاً عن ذلك، فإنَّ وثيقةَ الزواج الرسمية يُدوَّن فيها ما يُثبت اعترافَ الولي بقبض مقدم الصداق، مما يَحول دون أي نزاع في هذا الأمر. كفالة الصداق: ومع ذلك، فإنَّه في الحالات التي لا يقبض فيها الصَّداق على النحو السابق، فإنَّه من حق الزوجة أو وليِّها المطالبةُ بكفيل يضمن الوفاءَ بحق الزوجة؛ حتى تستوثِقَ من حصولها على صداقها؛ منعًا للنِّزاع في المستقبل، فإذا قام الزوجُ بالوفاء ينتهي الأمر ولا إشكال، ولكن إذا ما قام الكفيلُ بالوفاء، فإنَّه يكون من حقه الرجوعُ على الزوجِ بما أوفى للمرأة من صداق مفروض. النزاع بين الزوجين في وصف المقبوض: أهو هدية أم صداق؟ قد يختلف الزوج مع زوجته بالنسبة لبعض الأموال التي أعطاها لزوجته، فادَّعى أن ذلك من الصداق، وادعت هي أنَّه قدمه لها على سبيل الهَدِيَّة. والفَصْل في ذلك إنَّما يكون حسب البيِّنة التي تؤيد إحدى الدعويين، فمن قامت له البينةُ بصِحَّةِ دعواه، حُكِم له بما ادَّعاه، فإذا لم توجد بينة لكل منهما، وَجَب الرجوع إلى العرف السائد بالنسبة للأشياء المقدمة، فإذا كان العرف يقضي باعتبارها من الهدايا، فلا حقَّ للزوج فيها، وإذا كان العُرف يعدُّها من الصَّداق كانت حقًّا للزوج، ومِنْ ثَمَّ فلا يطالب من الصداق إلاَّ بالمقدار الذي يبقى بعد تنزيل ما حكم له به. إعداد بيت الزوجية: بقيت معنا كلمةٌ موجزة عن إعداد بيت الزوجية، والأصلُ أن هذا الإعداد يقع شرعًا على عاتق الزوج، وهو ما عليه العُرف في كثير من البلدان الإسلامية. وعلى ذلك، فالزوجة ليست مسؤولة عن أيِّ شيء في تكوين بيت الزوجية وإعداده وتجهيزه؛ بل ما تقبضه من صَداق هو خالص حق لها، أو هو منحة وعطية لها من الله - تعالى - فلا تطالَب بأن تأتي بشيء منه في المنزل، اللهم إلاَّ أن تحتاج هي إليه شخصيًّا من زينة وعطور وثياب. وبهذا قال فقهاء المذهب الحنفي؛ حيث ألزموا الزوجَ بكل ما يحتاج إليه بيتُ الزوجية من أثاث وأدواتٍ وما إلى ذلك، وهو المعمول به قضاءً في مصر؛ حيث لا يوجد نصٌّ خاص في هذا الشأن، فيكون المعمول به الراجح من المذهب الحنفي. وأمَّا المالكية، فقد قالوا: إنَّ الزوجةَ ملزمَة بتجهيز نفسِها بما قبضتْه من مهر، ما لم يوجد شرط أو عُرف يقضي بغير ذلك. وقد جرى العُرف بمدينة القاهرة وبعض المدن المصرية على أنَّ الزوجةَ تقوم بتجهيز منزل الزوجية، وأنْ يُنظر إلى الصداق المدفوع باعتباره جزءًا من ثمن الجهاز المطلوب، في حين أنَّ ما يقوم به ولي الزوجةِ يعد شيئًا كبيرًا بالنسبة لما يدفعه الزوج من صداق. ولا أعتقد أنَّ هذا العُرف يُمكن تخريجه على المذهب المالكي؛ لأنَّ هذا المذهب يرى أنَّ الزوجة تقوم بالتجهيز في حدود صداقها. والذي أراه أن المقصود من الشرط والعُرف عند المالكية، هو الشرط المشروع الذي لا ظلمَ فيه ولا إجحافَ بأحد، وأنَّ العُرف المقصود عندهم هو العرف في ظل الأحكام الإسلامية، وهو العرف الشرعي. والذي يبدو لنا أن ما جرى به العرف المشار إليه في بعض المدن المصريَّة الكُبرى، هو عُرفٌ دخيل على النظام الإسلامي، ولعله وفد إليها من البِدَع الوافدة، وما أكثرَها في النظم القانونية والاجتماعية في مصر! وهنالك في ريف مصر وكثير من بُلدانها الأخرى، مَن لم يتأثروا بهذا العُرف الوافد؛ تمسُّكًا منهم بالقاعدة الأصلية؛ حيثُ يقوم الزوجُ بسائر التكاليف، وإن كان الصداقُ جزءًا منها، فلا بأس بذلك؛ تخريجًا على المذهب المالكي، والله ولي التوفيق. المطلب الثاني: في نفقة الزوجية: نفقةُ الزوجية هي الحقُّ الثاني من الحقوق المالية الثابتة شرعًا للزوجة. وتعرف النفقة شرعًا بأنها: الشيء الذي يبذلُه الإنسان فيما يحتاج إليه هو أو غيره من الطَّعام والشراب ونحوهما، بمعنى أنْ يقوم الزوج بجميع ما تحتاج إليه زوجته من طعام وثياب ومسكن مناسب، وسائر ما يلزمها وتتطلبه حياتها معه في الحدود المشروعة وحسب إمكانياته. أصل وجوب النفقة: والأصل في وجوب نفقة الزوجية: الكتاب، والسنة، والإجماع. أما الكتاب، فقوله - تعالى -: ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴾ [الطلاق: 7]، وقوله - سبحانه -: ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: 233]، وقوله - عزَّ وجلَّ -: ﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلاَ تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: 6]. وإذا كانت هذه الآيات المباركات قد نزلتْ في حقِّ المطلقات والإنفاق عليهنَّ في فترة العِدَّة، فإنَّ الله - جلَّت حكمتُه - يُعطينا المثل الأعلى في المعاملة الطيبة الرَّحيمة، فإذا كان الشأن في معاملة المطلقة فترةَ العِدَّة هكذا، فما بالُكَ بمعاملة الزوجات؟ وأما السنة، فقد بيَّن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - أحكامَ الله - تعالى - بيانًا شافيًا؛ حيثُ وردت الأحاديثُ الصحيحة التي كادت تبلغ حدَّ التواتُر، والتي جاءت لتؤكد وجوبَ نفقة الزَّوجة على زوجها. ولقد قال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - في خطبته يومَ عرفة في حجة الوداع: ((اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانةِ الله، واستحللتم فروجَهن بكلمةِ الله، لكم عليهن ألاَّ يوطئن فراشَكم من تكرهون، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف))، وعن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - أنَّ امرأة أبي سفيان قالت: يا رسول الله، إنَّ أبا سفيان رجل شحيح، ليس يُعطيني ما يَكفيني وولدي، إلاَّ ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: ((خذي ما يكفيك وولدَك بالمعروف)). وقد أجمعت الأمةُ في سائر عصورها على الامتثال لهذه النصوص، وتنفيذ حكم الله - تعالى - الذي أوجبَ على الزوج أن يُنفق على زوجته في حدود إمكانياتِه. سبب وجوب النفقة: والنفقة تَجب على الزوج؛ بسببِ تفرُّغ الزوجة لحياتها الزوجية بناءً على عقد الزواج الصحيح، فإذا أبرم العقد صحيحًا، وتوافرت سائر أركانه وشروطه، ثم أخذ الزواج صورته المتكاملة بالدخول والاستقرار في بيتِ الزوجية، فإنَّ نفقةَ الزوجة تصبح واجبةً على الزوج شرعًا من لحظة استقرارها في بيته. مقدار النفقة: وقد فصل الله الأمرَ في مِقدار النفقة، فهو اليُسر والتعاوُن والعَدل، لا يَجور هو، ولا تتعنَّت هي، فمن وسَّع الله عليه رزقَه، فينفق مما أسبغ الله عليه من نِعَم، سواء في المسكن أم في نفقة المعيشة، ومن قُدِرَ عليه رزقُه فلا حرجَ عليه ولا بأس أن يُنفقَ على قدر حاله، فالله - تعالى - لا يطالبُ أحدًا أنْ ينفقَ إلا في حدود ما آتاه، فهو المعطي، ولا يَملكُ أحد أن يُعطي على غير ما أعطاه الله، فليس لنا من مصدر آخر للعَطاء غير هذا المصدر، وليست هنالك خزانة غير هذه الخزانة؛ ﴿ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ﴾ [الطلاق: ، ثم لمسة الإرضاء وإفساح الرَّجاء للاثنين على السواء؛ ﴿ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴾ [الطلاق: ، فالأمر منوطٌ بالله في الفَرَج بعد الضيق واليُسر بعد العسر. هذا هو الأساس في تقدير النفقة؛ حيثُ يَنبغي أن يكون على هدي هذا التوجيه الإلهي الرَّحيم. ولا يتصور إلا أن يُجمِع الفقهاء على العمل بهذا الأساس العظيم، إلاَّ أن بعض فقهاء المذهب الحنفي قالوا بوجوب تقدير النَّفقة على أساس حال الزوج وحال الزوجة أيضًا، فإن كانا مُوسِرَين، وجب تقدير نفقة اليسار، وإن كانا غير ذلك قدرت نفقتها على قدر حالها وحاله، وإن كان أحدهما موسرًا والآخر معسرًا، قدرت لها نفقة الوَسَط. وقد كان العمل في مصر على هذا المذهب قبل صدور المرسوم بقانون 25 لسنة 1929؛ حيثُ اعتبر حال الزوج هو الأساس في تقدير نفقة الزَّوجة، نصت على ذلك المادة 16 من هذا المرسوم بقانون، إلاَّ أن هذه المادة قد طرأ عليها التعديل حديثًا بالقانون رقم 44 لسنة 1979م، ولكنَّ هذا التعديل لم يَمس الأساس السابق، وهو جعل حال الزوج هو أساسَ التقدير، وإنَّما اشترط الوفاءَ بالحاجيات الضرورية للزوجة في حالة العُسر، وفي هذا تقول المادة 16 بعد تعديلها بالقانون رقم 44 لسنة 1979: "تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها، على ألاَّ تقل النفقة في حالة العُسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية. وعلى القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوافُر شروطه، أنْ يفرضَ للزَّوجة في مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رَفع الدعوى نفقة مؤقتة (بحاجتها الضَّرورية) بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورًا، إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ. وللزَّوج أن يُجري المقاصَّة بين ما أداه من النفقة المؤقتة، وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائيًّا؛ بحيثُ لا يقل ما تقبضه الزوجة عن القدر الذي يَفي بحاجتها الضرورية". والأحكام التي جاء بها هذا النص تتلخص فيما يأتي: أولاً: أبقى الأساس السابق في أنَّ تقدير نفقة الزوجة يكون بحسب حال الزوج يُسرًا أو عسرًا. ثانيًا: أوجب على القاضي فرض نفقة مُؤقتة للزوجة في حالةِ قيام سبب استحقاق النفقة، وتوافر شروط هذا السبب، وذلك في خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدَّعوى بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورًا إلى أنْ يتم الحكم في النزاع. وهذا الحكم يُعَدُّ إحدى حسنات القانون 44 لسنة 1979م؛ لأنَّه يقضي على مشكلة حيرة الزوجة في حصولها على نفقتها، وما تلاقيه من متاعبَ بسببِ الإشكالات والتأجيلات، مع ملاحظة أنَّ الشريعة الإسلامية ليست هي المسؤولةَ عن تلك الإجراءات المعطلة لحصول الزوجة على نفقتها؛ وإنَّما المسؤول الأول عن ذلك هو عدم الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية منهجًا وسلوكًا. ثالثًا: أعطى الزوج حقَّ إجراء المقاصة بين ما أدَّاه من نفقة مُؤقتة، وبين ما حكم به نهائيًّا للزوجة؛ بحيث يترك لها ما يفي بحاجتها الضَّرورية. طريقة الإنفاق: أمَّا عن طريقة الإنفاق وكيفيته، فهي موكولة إلى الأفراد حسب ما يتراءى لهم، والمتبَع عادة أنْ يقوم الزوج بالإنفاق على بيته، وذلك بتوفير كل ما يلزمه، وهو بهذه الطريقة يوفر لزوجته سائرَ ما تحتاج إليه، فتكون الزوجة بهذا قد استوفتْ نفقتها، وهذه الطريقة تسمى طريقة التمكين، وهي الطريقة المُثلى. وهنالك طريقة أخرى تسمى طريقة التمليك، وهي أنْ يُقدَّر لها مبلغٌ معين من المال، يسلمه الزوج لها، فتقوم هي بالإنفاق على نفسها منه، وتدبير احتياجاتها، وتقديرُ هذا المبلغ قد يكون بالاتِّفاق، وقد يكون بالقضاء، ومن المعلوم أنَّ الاتِّفاق هو في الظروف العادية، وأمَّا تقدير القاضي فالغالب أن يكون عند النِّزاع والشقاق. شروط وجوب النفقة: يشترط حتى تكون النفقة واجبةً للزوجة أنْ تتوافر الشروط الآتية: 1 - أن يكون عقد الزواج صحيحًا، فإذا كان باطلاً أو فاسدًا، فلا تترتب عليه نفقة واجبة. فلو أنَّ زواجًا أُبْرِم بين رجل وامرأة، ثم تبين بعد ذلك أنَّ المرأة أخت له من الرَّضاع، فإنَّ العقد لا تترتب عليه نفقة واجبة، ولكن لو كان قد أنفق عليها من قبلُ باختياره، فإنَّه لا يحق له الرجوع عليها بما أنفقه، وأما إذا كان الإنفاق عليها بحكم القاضي - وهذا نادر في مثل هذه الظروف - فإنَّه يستطيع الرجوع عليها بما أنفق عليها؛ لأنَّ إنفاقه بحكم القاضي ينفي نيةَ التبرع؛ فكان له مطالبتها. 2 - أن تكون الزوجة صالحة لأداء واجباتِها الزوجية، فإذا كانت غير صالحة للحياة الزوجية، فالقاعدة العامة أنَّه لا نفقةَ لها، ولكن قد يرد على ذلك بعضُ تحفُّظات نشير إليها بعد قليل. 3 - أن تستقرَّ الزوجةُ في بيت الزوجية، فلكي تستحقَّ نفقتها الزوجية؛ يتعيَّن عليها ألاَّ تضيع حقَّ الرجل في استقرار زوجته في بيته، وهو ما أسماه الفقهاء "حق الاحتباس"؛ أنَّ الزوجة تستقر في بيت زوجها لأداء واجباتها الشرعية ولا تخرج إلاَّ بإذنه. فإذا توافرت هذه الشروطُ، وجبتْ لها النفقة بإجماع العلماء، ولكن إذا تخلفت أو تخلَّف بعضها، فإنَّ الزوجة لا تجب لها النفقة. وقد ذكر الفقهاء تطبيقاتٍ لتخلُّف هذه الشروط أو بعضها، نشير إلى أهمها فيما يلي: أولاً: إذا كانت المرأةُ ناشزًا، فلا نفقةَ لها، ومظهرُ نشوزها تركُها لبيت الزوجية، أو امتناعها عن الانتقال إلى بيت الزوجية بلا مبررٍ مشروع، فهي بهذا الامتناع أو بذلك التَّرك تُعَدُّ ناشزًا، ويسقط حقها في النفقة. ثانيًا: إذا كانت الزوجةُ مريضة، فإن كان مرضُها سابقًا، بأن كانت مريضةً في بيت أبيها قبل أن تزف إلى زوجها، وكان المرضُ يَمنعها من الانتقال إلى منزل الزوجية، فإنَّه لا نفقةَ لها بالإجماع، فإن كان في إمكانها الانتقالُ إلى بيته، وطَلَبها فامتنعت، فلا نفقةَ لها أيضًا. وأمَّا إنْ كان مرضُها لاحقًا، بأن زفِّتْ إلى زوجها ثم مرضت، فـ "لها النفقة ما دامت في بيت الزوجية، ولو كان مرضها مزمنًا؛ وذلك لأنَّ الاحتباس قد تم كاملاً، والمرض عارض، وهو كيفما كان قابلٌ للزوال، والحقوق الدَّائمة لا تسقط بالأمور العارضة، ولأن حسن العشرة يوجب أن يتحمل كلُّ واحد منهما صاحبَه في مرضه وسقمه". وقد نصَّ القانون رقم 44 لسنة 1979 على هذا الحكم في المادة الثانية[81] منه، فقال: "ولا يَمنع مرضُ الزوجة من استحقاقها للنفقة... وتشمل الغذاء، والكسوة، والمسكن، ومصاريف العلاج...". وإضافة مصاريف العلاج إلى مشتملات النَّفقة يُعَدُّ أمرًا حسنًا توجبه المروءة، ويُحتِّمه حسن العشرة بين الزوجين، لا سيما إذا كان الزوج موسرًا. ثالثًا: إذا سافرت الزوجةُ من دون إذنِ زوجها وبلا مَحرَم معها، فإنَّ سفرها معصية لله - تعالى - ومخالفة لزوجها، فهي عاصية من جميع الوُجوه، فلا نفقةَ لها بالإجماع. وإذا كان زوجها قد أذِن لها، ولكنها سافرت من دون مَحرم معها، فإنَّها عاصية أيضًا ولا نفقة لها. أمَّا إذا كان سفرها مع محرم وبإذن زوجها، فهو سفر مُباح، وتستحق النفقة أثناء هذا السفر المشروع. ومن باب أولى إذا سافرت مع زوجها، فنفقتُها واجبة عليه إجماعًا، ومن ناحية أخرى فإنْ كان سفرُها لأداء فريضة الحج، فيتعيَّن النظر في وقت هذا السفر إنْ كان سفرها للحج قبل أن تزف إلى بيت زوجِها، فالحكم هنا في غاية الوضوح؛ حيث لا نفقةَ لها؛ لأنَّها لم تستوفِ شروط وجوبها. فإن زُفَّت إلى زوجها واستقرَّت في بيتها، ثم خرجت إلى أداء الفريضة من دون إذن زوجها وبلا محرم، فلا نفقةَ لها؛ حيث لا يجوز لها مثل هذا السفر، أمَّا إذا سافرت مع زوجها، فنفقتها واجبة لها إجماعًا. أمَّا خروجها للحج نافلةً - بأن كان قد سبق لها الحج قبل ذلك - فلا تستحقُّ نفقة في هذا السفر، إلاَّ أن يتطوَّع الزوج، فهذا شأنه. بقيت معنا حالة ما إذا خرجتْ لأداء الفريضة مع مَحرم لها ومن دون إذن زوجِها، فذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن إلى أنه لا نفقةَ لها؛ لأنَّها بسَفرِها قد ضيعت حقَّ زوجها فتسقط نفقتها، وذهب أبو يوسف وبعض الفقهاء إلى أنَّها تستحق النفقة في هذه الصورة؛ حيث إنَّها خرجت لأداءِ الفريضة، وهو من الضروريات التي تُبيح لها الخروج، فيظل حقها في النفقة ثابتًا. والذي نراه - والله أعلم - أنَّه يتعين النظر في السبب الذي من أجله لم يأذن لها زوجُها بالخروج، فإن كان سببًا مشروعًا، بأن كان لها صبية صغار لا يستغنون عنها، ولا يستطيع الزوج القيام بواجباتِهم، فتعنَّتت وأصرت على الخروج، في حين أنَّ لدى زوجها من الأعذار المشروعة ما يَجعلها في حكم غير القادرة؛ لأنَّ حقَّ الأطفال الصغار مقدمٌ على الخروج حتى في هذه الظروف؛ حيثُ فرض الله الحجَّ على القادرين، ووجود أطفال بهذه الصورة يَجعلها في حكم غير المستطيعة، فهنا تسقط نفقتها على الرَّغم من أنها خرجت لأداء الفريضة. أما إذا كان زوجُها لا يريد لها أداء الفريضة، وليس لديه من الأعذار ما يدْعوه إلى عدم الإذن لها، فهنا يكونُ عدم إذنه تعنُّتًا من جانبه، فلا تسقط نفقتها، لا سيما إذا كان بُخلُه أو عدم تديُّنه هو الدافع إلى عدم الإذن. ولكن ما حكم امتناعها عن السفر مع زوجها؟ في هذه الحالة: نتكلم عن سفر الزوج، لا عن سفر الزوجة، فإذا كانت ظروفُ الزوج تقتضي أن يسافرَ إلى مكانٍ ما فترةً تطول أو تقصر لعمل أو دراسة، فإنَّ من حقه أن يصطحب معه زوجته في سفره. ولكن ما الحكمُ فيما لو امتنعت الزوجة عن السفر؟ الجواب: إنَّ السفر إذا كان لمصلحة كما أشرنا، وكان هو مأمونًا عليها، فإن من حقه أنْ تسافر معه، ولا يَجوز امتناعها عن هذا السفر، فإنْ كان امتناعها بلا مُبرر شرعي، فيسقط حقها في النفقة، أمَّا إنْ كان السفرُ إضرارًا بها، فإنَّ الله قد رفع الضر عن عباده، وحَرَّم الظلم على نفسه، وجعله بين عباده محرمًا، فمن كان في مقر عمله وله مسكنه في هذا المقر، ولكنَّه أراد أن ينقل زوجته من هذا المسكن إلى القريةِ أو البيت الذي له في مَزرعته، وإنْ كان غير مأمون عليها، فإنَّ السفر هنا لا مبررَ له، فإنِ امتنعت فامتناعها بحقٍّ شرعي، فلا تسقط نفقتها. رابعًا: خروج الزوجة للعمل: إذا كانت الزوجة تباشر عملاً يستدعي بقاءها خارج منزل الزوجية فترةً تطول أو تقصر، فإذا كان ذلك بموافقة الزوج، فإنَّ نفقتها لا تسقط؛ لأنَّه قد رضي هو بإسقاطِ بعض حقه في استقرارِ الزوجة في بيته؛ أي: إنَّه قد رضي بالاحتباس الناقص على حدِّ تعبير الفقهاء. أمَّا إذا كان خروجها للعمل من دون إذنه، سواء كان عدم إذنه مشروطًا عند العقد، أم طلب منها أثناء حياتهما الزوجيَّة ترك العمل فرفضت، فإنَّ رفضَها يُسقط حقَّها في النفقة؛ لأن رفْضها طلبَه يُعَدُّ نشوزًا منها، والناشز لا نفقةَ لها، كما هو مقرر شرعًا. وقد تعرض القانون رقم 44 لسنة 1979 الفقرة الخامسة من المادة الثانية منه لذلك؛ حيث تقول: "ولا يعد سببًا لسقوط نفقة الزوجية خروجها من مسكن الزوجية من دون إذن زوجها، في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع، أو يجري بها العُرف، أو عند الضرورة، ولا خروجها للعمل المشروع، ما لم يظهر أنَّ استعمالها لهذا الحقِّ المشروط مشوب بإساءة استعمال الحقِّ، أو منافٍ لمصلحة الأسرة، وطلب منها الزوج الامتناع عنه". وبأدنى تأمُّل في هذا النص يظهر أنه معيب من وجهين: الأول: أنَّ عبارة "في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع، أو يجري بها العُرف، أو عند الضرورة" تفتحُ بابًا واسعًا لمخالفةِ أحكام الشريعة الإسلامية الثابتة بالنصِّ الصريح؛ لأنَّ ظاهر هذه العبارة يستفاد منها احترام العُرف المغاير لحكم الشرع؛ لأنَّ العطف يقتضي المغايرة، ومُقتضى العطف بـ(أو) في هذا النص يُفيد هذا الفهم حسب المعنى اللُّغوي للعبارة، ومثل ذلك يقال بالنسبة لعبارة: "أو عند الضرورة". والحق أنَّ جملة "الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع" فيها الكفاية عن كل ما عداها بعد ذلك؛ لأنَّ العرف الصحيح شرعًا هو من الأحكام الثابتة بحكم الشرع، كما أن قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات" قاعدة شرعية ثابتة بالكتاب والسنة. الوجه الثاني: أنَّ عبارة "ولا خروجها للعمل المشروع، ما لم يظهر أنَّ استعمالها لهذا الحقِّ المشروط مشوبٌ بإساءة الحقِّ أو منافٍ لمصلحة الأسرة، وطلب منها الزوج الامتناع عنه"، ويبدو لنا أن هذا الجزء من النص يتضمن بعضَ الملاحظات؛ حيثُ يفهم منه أنَّ الزوج لا يحق له أن يطلبَ من زوجته الامتناع عن الخروج إلاَّ إذا ظهر أن استعمالها لهذا الحقِّ المشروط مشوب بإساءة الحق، وأنه منافٍ لمصحة الأسرة، عند ذلك له أن يطلبَ منها عدم الخروج، ثم إنَّ التعبير بالفعل "يطلب" يُشعر بأنه قد فَقَد حَقَّ الطاعة الثابت له شرعًا؛ لما له من قوامة عليها أثبتها الله ربُّ العالمين، كما أنَّ تقديم الحق المشروط في أول العبارة، ثم بعد ذلك تأخير الحق الأساسي الثابت شرعًا للزوج وجعله في نهاية الفقرة - كل هذا يصور النصَّ وكأنه جعل الاستثناء أصلاً، وجعل الأصل استثناء. ولعلَّ في صياغة العبارة على النحو التالي ما يُؤكد الحقوق الثابتة لأهلها، ويَجعلها تتفادى ما قد يُلاحظ عليها من مأخذ: "ولا خروجها بإذن زوجها للعمل المشروع، ما لم يظهر أنَّ هذا الخروج منافٍ لمصلحة الأسرة، أو أنَّها أساءت استعماله". ........ 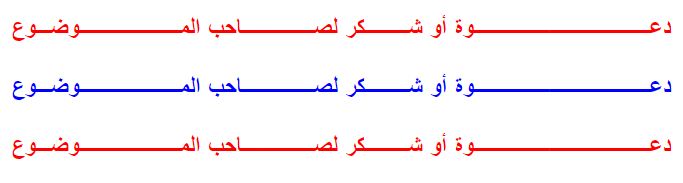  الموضوع الأصلي : حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: houdib69 
   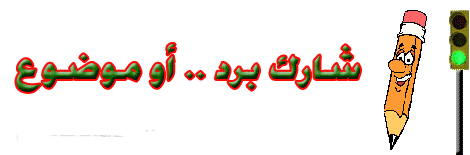
| ||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
 الثلاثاء 10 نوفمبر - 14:28 الثلاثاء 10 نوفمبر - 14:28 | المشاركة رقم: # | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  موضوع: رد: حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي موضوع: رد: حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي  حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي مسكن الزوجية: حقُّ الزوجة في النفقة يشمل - كما أشرنا - الطعامَ، والكساء، والمسكن، وسائر ما تحتاجه في الحدودِ الشرعية، ولما كان المسكنُ يَحتاج إلى بعض شروطٍ مُعينة، وَجَب تَخصيصه بالذِّكر في هذا المقام؛ حيث يتعيَّن على الزوج أن يُهيئ لزوجته المسكنَ المناسب؛ حتى يُمكن القول بأنَّه قد أدَّى واجبه في هذا الصَّدد، وحتى يُمكن القول بأنَّ المسكن مناسبٌ شرعًا؛ يتعين أنْ تتوافر الشروط الثلاثة الآتية: الشرط الأول: أنْ يكون مشتملاً على كل ما يلزم السكن؛ من أثاثٍ، وفراش، وآنية، ومرافق، وغيرها مما تحتاجه الأسرة، ويُراعى في ذلك حالة الزوج المالية من يَسار وإعْسار ووضعه الاجتماعي. الشرط الثاني: أن يكون خاصًّا بالزوجين دون غيرهما، باستثناء ولده الذي لم يبلغ سنَّ التمييز، فإذا كان مشغولاً بسُكنى أحدٍ مَهْمَا كان قريبًا، فإنَّه لا يعد سكنًا شرعيًّا؛ حيث لا تحقق فيه للزوجة حريتها الكاملة. الشرط الثالث: أنْ يكون المسكنُ مأمونًا، وإلاَّ فلا يُعَدُّ مسكنًا على الإطلاق؛ بل إنَّ مظاهر الأمن فيه أنْ يكون بين جيران صالحين؛ حتى تكونَ الزوجةُ آمنةً فيه على نفسها ومالها، ويلاحظ أنَّه إذا كان متزوجًا بأخرى، فإنَّ وجود هذه الزوجة في مسكنٍ مُجاور لها يعد إخلالاً بشرعية المسكن إذا كانت تتأذى من وجودها. فإنْ أعد لها مسكنها بشروطه السابقة، وجب عليها الاستقرارُ فيه، ولا تَخرج منه إلاَّ بإذنه، أمَّا إذا امتنع عن إعداد هذا المسكن، أو أعدَّ مسكنًا لا تتوافر فيه الشروطُ السابقة، فإنَّ من حقها أن تطالبه بأجرة مسكن شرعي، فيما لو أمكنها تدبير المسكن من جانبها. نفقة الخادم: سبق أن أشرنا إلى أنَّه من واجبات الزوجة أنْ تقومَ بخدمة بيتها، والإشراف على شؤون أولادها، وأنَّ هذا هو الأصل الذي عليه العمل في مختلف العصور. على أنه إذا كان الزوجُ موسرًا، وفي استطاعته أن يأتي لها بخادم، فذلك من مُقتضيات حسن العشرة، ويُصبح هذا واجبًا عليه إذا كان لها - من قبل - خادمًا في بيت أبيها، وكذلك إذا بلغ هو من اليسار بحيث تُخدَم زوجته، فيكون من الواجب عليه أنْ يأتي لها بخادمٍ إنْ كان ذلك ممكنًا. أمَّا القول بأنَّ عليه أن يدفع لها أجرة خادم، فهذا لا يتفق - في نظري - مع حسن العشرة والتعاوُن المفترضِ وجودُه بين الزوجين، فالخادمُ واجب عليه إنْ كان الزوج موسرًا وأمكن وجود الخادم، فإنْ لَم يُمكنه ذلك بأن كان غير موسر، أو كان موسرًا ولم يتيسر وجود الخادم، فلا شيء عليه. غياب الزوج وأثره على النفقة: إذا كان الزوج غائبًا؛ ولكنه ترك لزوجته ما تُنفق منه، فلا إشكال؛ لأنه قام بواجب الإنفاق في هذه الحالة. وقريب من هذا لو كان في بيته مالٌ مُدَّخر، وقد نَفَد ما تركه لزوجتِه على سبيل النَّفقة، فإنَّه يَجوز لها شرعًا أن تأخذَ من مالِ زوجها ما يَكفي لنفقتها بالمعروف، والأصلُ في هذا: الحديث المتقدم الذي قال فيه النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)). ولكن الإشكال إذا غاب الزوجُ ولم يترك مالاً، والحكمُ في هذه الحالة يتضمَّن تفصيلات كثيرة، ليس الآن مجالها. وخلاصةُ القول في هذه الحالة: أنَّ القانون المصري استقى أحكامَها من فقه الأئمة الثلاثة: مالك، والشافعي، وأحمد، القائلين بأنَّ نفقة الغائب كنفقة الحاضر، فإذا كان له مالٌ ظاهر، ثبت حق الزوجة في هذا المال، وإنْ لم يكن له مال ظاهر، أنذره القاضي بالطرق الرسمية: إمَّا أن يحضر لينفق على زوجته، وإمَّا أن يرسل ما تنفق منه، فإنِ امتنع جاز للقاضي بناء على طلب الزوجة أنْ يتخذ معه إجراء آخر. هذا كلُّه إذا كان غائبًا غيبة قريبة وفي مكان معلوم، أمَّا إذا كان في غيبة بَعيدة ولا يسهل الوصول إليه، أو مَجهولَ المحل أو مفقودًا، فإنَّ هذه الحالاتِ لها أحكام أخرى، نتكلم عنها في القسم الثاني - إن شاء الله تعالى. هذا، والأحكام السابقة - وغيرها - تضمَّنها المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1920؛ حيث نص في المادة الخامسة منه على ما يأتي: "إذا كان الزوجُ غائبًا غيبة قريبة، فإن كان له مال ظاهر، نفذ الحكم بالنفقة في ماله، فإنْ لم يكن له مال ظاهر، أعذر إليه القاضي بالطُّرق المعروفة، وضرب له أجلاً، فإن لم يرسل ما تنفق زوجته على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها...". ومعنى مال ظاهر: مالٌ معروف، يُمكن التنفيذ عليه بالطرق القانونية، أو يُمكن أن تستوفي الزوجة نفقتها منه بسهولة. دَين النفقة: يرى الحنفية أن نفقة الزوجة لا تكون دَينًا قويًّا إلا بتوافر الشرطَين الآتيَين: الشرط الأول: أن تكون النفقةُ مقدرة بالاتفاق بين الزوجين أو بحكمٍ من القضاء. الشرط الثاني: أن تكون الزوجة قد أذنت بالاستدانة من الزوج أو من القاضي، وقامت فعلاً باستدانة النفقة على حساب زوجها. فإذا توافر هذان الشرطان بتمامهما، فإنَّ المبالغَ التي استدانتْها باعتبارها نفقةً تكون دَينًا قويًّا في ذمة الزوج، ومعنى الدَّين القوي أنه لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء. ويذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن نفقةَ الزوجة تعدُّ دينًا قويًّا من وقت وجوبِها على الزوجة، دون أن تتوقفَ على أي أمر آخر، فهي لا تتوقف على اتفاقٍ ولا حكم، ولا على إذن أو استدانة؛ ذلك أنَّها حقٌّ ثبت للزوجة شرعًا على زوجها، فإنْ قصر في أدائها تكون دينًا في ذمته لا يسقط عنه إلاَّ بالأداء أو الإبراء، شأن النفقة في ذلك شأن سائر الديون الثابتة. وفي زمن سابق كان العملُ في مصر على مُقتضى المذهب الحنفي، ولكن عندما صدر المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1920 نصَّ في المادة الخامسة منه على ما يأتي: "تعدُّ نفقة الزوجة التي سلَّمتْ نفسها لزوجها ولو حكمًا، دينًا في ذمته، من وقت امتناع الزوج عن الإنفاق مع وجوبه، بلا توقُّف على قضاء أو تراضٍ بينهما، ولا يسقط دينها إلا بالأداء أو الإبراء". وبهذا صارت نفقة الزوجة دينًا ثابتًا في ذمة الزوج لا بد من وفائه؛ أخذًا بمذهبِ الأئمة الثلاثة - رضي الله عنهم - فهو لا يسقط، لا بنشوز ولا بطلاق، ولا حتى بوفاة، وعلى حد تعبير النص "لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء". غَيْر أنَّ هذا النص لم يُحدد مدةً يَجب وفاءُ دين النفقة عنها؛ ولذا فقد أُسِيء استخدامُه برفع الدَّعاوى الكيديَّة عن مُددٍ سابقة تزيد عن الحدِّ المعقول، فجاء المرسوم بقانون 78 لسنة 1931 بعلاجٍ لهذا الموقف، فنص في المادة 99/ 6 على منع سَماع دعوى النفقة لفترة سابقة تزيد عن ثلاثِ سنوات ميلادية نهايتها تاريخ رفع الدعوى. وإذا نظرنا إلى الواقع العملي، رأينا أنَّه من النادر أنْ يظل زوج ممتنعًا عن الإنفاق على زوجته لمدةِ ثلاث سنوات، وإذا افترضنا ذلك جدلاً، فمن المستحيل أنْ تسكت زوجة لمثل هذه المدة دون أن تطالب بالإنفاق؛ لذلك فإنَّ هذا النص قد أسِيء استعماله أيضًا، فأصبحت معظم دعاوى النفقة تُرفع عن مدة ثلاثِ سنوات سابقة، بغضِّ النظر عن الصدق والواقع. فلما صدر القانون رقم 44 لسنة 1979 أكَّد أن دَين النفقة لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، ولكنَّه منع سماع الدعوى عن نفقةٍ لمدة تزيد عن سنة واحدة. وتلك حسنة أخرى من حسنات القانون رقم 44 لسنة 1979م. ومن ناحية أخرى، فإنَّ هذا القانون قد نص على أنه لا يقبل من الزوج التمسُّك بالمقاصة بين نفقة الزوجة، وبين دين له عليها، إلاَّ فيما يزيد على ما يفي بحاجتها الضَّرورية. وقد سبق أن قلنا: إنَّ هذا الحكم يتَّفق مع أحكام الشريعة التي تحرص على الوفاء بالحاجات الضرورية للإنسان، وهي مقدمة على الوفاء بالديون. ومن هنا، فقد نصَّ هذا القانون أيضًا على أنْ يزن لدَين نفقة الزوجة امتيازًا على جميع أموال الزوج، ويتقدَّم في مرتبته على ديون النفقة الأخرى. وهذه الفقرة هي أيضًا حسنة تضاف إلى حسنات القانون 44 لسنة 1979؛ حيث قضى بهذا "على تلاعب بعض الأزواج الذين كانوا يطلبون من بعض من وَجَبت نفقتهم عليه رفع دعاوى نفقة؛ لعرقلة حصول الزوجة على نفقتها، أو تقليل القدر الذي تحصل عليه الزوجة؛ حيث يتقاسم هؤلاء مع الزوجة القدرَ المخصص للتنفيذ به على الشخص من دخله". الامتناع عن تنفيذ حكم النفقة وعقوبته: تنص المادة 347 من المرسوم بقانون 78 لسنة 1931 على أنَّه: "إذا امتنع المحكومُ عليه من تنفيذ الحكم الصادر في النفقات، يُرفع ذلك إلى المحكمة الجُزئية التي أصدرت الحكم، أو التي بدائرتِها محلُّ التنفيذ، ومتى ثبت لديها أنَّ المحكوم عليه قادرٌ على القيام بما حُكِم به وأمرتْه ولم يَمتثل، حكمتْ بحبسه، ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس عن ثلاثين يومًا، أما إذا أدى المحكوم عليه ما حكم به، أو أحضر كفيلاً، فإنَّه يُخلى سبيلُه، وهذا لا يَمنع من تنفيذ الحكم بالطرق الاعتيادية". وظاهر من هذا أنَّ الممتنع عن تنفيذ حكم النفقة، يُرفع أمرُه إلى القضاء مرة أخرى؛ للنَّظر فيه، فإن كان قادرًا على الوفاء أَمَره بذلك، فإنْ أدَّى ما عليه أُخْلِي سبيله، وكذلك يخلى سبيله إذا أحضر كفيلاً يضمن أداءَ المبلغ المحكوم به عليه، أمَّا إذا امتنع عن الوفاء ولم يُوجَد من يكفله، فإن المحكمة تأمُر بحبسه لمدة لا تزيد عن شهر، على أن يخلى سبيله في أي لحظة يقوم فيها بالسداد أو بتقديم كفيل. المبحث الثاني في الحقوق غير المالية للزوجة هذا النوع من الحقوق لا يقيد بمال؛ ولذلك فقد عبَّرنا عنه بالحقوق غير المالية، ويُمكن أن يطلق عليه الحقوق الأدبية أو الحقوق المعنوية، ولكنَّنا آثرنا التعبير الأول؛ لأنه حقوق شرعية أثبتها الله - تعالى - للمرأة، وهي حقوق ثابتة لها إلى جانب الحقوق المالية. وتتلخص هذه الحقوق في حقَّين أساسيين، هما: عدم الإضرار بالزوجة، والعدل في معاملتها. أولاً: عدم الإضرار بالزوجة: يقصد بعدم الإضرار بالزوجة أنْ يبتعد عن كلِّ ما يؤذيها، وقد نهى الله - تعالى - عن ذلك في نصوص كثيرة، منها قول الله - تعالى -: ﴿ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 231]، وقوله - تعالى -: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: 19]؛ أي: على ما أمر الله من حسن المعاشرة، فعلى الزوجِ أن يوفي حق زوجته، وأن لا يعبس في وجهها لغير ذنب، وأن يكون منطلقًا في القول، لا فظًّا ولا غليظًا. وهكذا فالنصوص القرآنية الواردة في هذا الشأن هي أوامرُ إلهيةٌ كريمة من الله - تعالى - إلى الأزواج، في أنْ يعاملوا زوجاتِهم معاملةً كريمة، وأن يُحسنوا عشرتهن، ولقد ضرب النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - المثلَ الأعلى في معاملة الناس، وفي معاملة نسائه بصفة خاصَّة، فقد رَوى أحمد والترمذي وصححه، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنُهم خلقًا، وخيارُكم خيارُكم لنسائهم))، وروى الترمذي وصححه، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((خيرُكم خيرُكم لأهله، وأنا خيركم لأهلي)). ثانيًا: العدل في المعاملة: أمَّا العدل في المعاملة، فيقصد به أنَّ الرجل إذا اضطرتْه ظروفُه إلى أن تكون له أكثر من زوجة - على النَّحو الذي بيَّناه فيما سبق - فإنَّه يَجب عليه شرعًا أن يعدلَ بين زوجاته في المعاملة من غير إضرارٍ بواحدة منهن، فينفق عليهن من غير تقيُّد حسب حالته المالية. على أنَّ العدل بين الزوجات إنَّما يكون في المسائل الظاهرة، التي هي في قُدرته، أمَّا الميل القلبي، فهو - كما أسلفنا - أمرٌ في غير مَقدورِ البشر؛ ولذلك صح في الحديث أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((اللهم هذا قَسْمي فيما أملك، فلا تَلُمني فيما تَملك ولا أملك)). الفصل الثالث في الحقوق المشتركة بين الزوجين 1 - حِلُّ المعاشرة. 2 - حسن العشرة. 3 - التوارث. 4 - حرمة المصاهرة. نقصد بالحقوق المشتركة تلك الحقوقَ الثابتة للزَّوجين معًا وعليهما معًا، فهي حقوق لهما، وفي الوقت نفسه هي بذاتها واجبات عليهما، ويُمكن تلخيص هذا النوع من الحقوق فيما يأتي: حِلُّ المعاشرة، وحسن العشرة، وحق التوارث، وحرمة المصاهرة. أولاً: حل المعاشرة من الحقوق الثابتة لكلٍّ من الزوج والزوجة أنَّ الله - تعالى - أحلَّ لكلٍّ منهما معاشرة الآخر، وقضاء الحاجة الجنسيَّة التي أودعها الله طبيعةَ بني البشر، وهذا الحِل إنَّما يكون في حدود ما أمر الله، فعلى الزوجة أن تجيب زوجَها وتلبيَ رغبته، وإلاَّ كانت آثمة. وفي الحديث الصحيح: ((إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فأبتْ أن تجيء فبات غضبان عليها، لعنتْها الملائكة حتى تصبح)). ومن ناحية أخرى، فإنَّه على الزوج أن يعفَّ زوجه ويُحصنها، وهذا واجبٌ عليه شرعًا؛ فقد رُوي أن عبدالله بن عمرو بن العاص كان يصوم نهاره كله، ويقوم ليله كله، فبلغ أمرُه النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - وقصته في رواية البخاري، عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((يا عبدالله، ألم أخبر أنَّك تصوم النهار، وتقوم الليل؟))، قلت: بلى يا رسول الله، قال: ((فلا تفعل، صُم وأفطر، وقُم ونم؛ فإنَّ لجسدك عليك حقًّا، ولعينك عليك حقًّا، ولزوجك عليك حقًّا)). على أنَّ هذا الحق المشروع للطرفين يتعيَّن أن يكون من حيث أمر الله - تعالى - فإذا وُجد مانع شرعي من ذلك، ارتفع الحل، وإذا زال المانع عاد الحل كما كان؛ يقول الله - تعالى -: ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ [البقرة: 222]. ثانيًا: حسن العشرة: أمر الله - تبارك وتعالى - بحسن العشرة في قوله - عزَّ وجلَّ -: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: 19]، وكما سبق أنْ أشرنا فإنَّ هذا الخطاب عام للجميع؛ إذ إنَّ لكل أحدٍ عِشْرةً زوجًا كان أو وليًّا، وإذا كان الأمر في الغالب للأزواج - كما أشرنا - فإن هذا لا يَمنع من دخول الزوجات في هذا الأمر عن طريق الدلالة؛ لأنَّهن مأمورات بطاعة أزواجهن، كما سبق أن بينَّا ذلك تفصيلاً، "فكلٌّ من الزوجين مطالبٌ بحسن العشرة، على معنى أنْ يسعى كلٌّ منهما إلى ما يُرضي الآخر؛ من حسن المخاطبة، واحترام الرَّأي، والتسامح، والتعاوُن على الخير، ودفع الأذى، والبعد عما يَجلب الشقاق والنِّزاع". ثالثًا: الحق في التوارث: جعل الله - تعالى - الزوجيةَ سببًا من أسباب التوارُث بين الزوجين، بمعنى أنَّ كلاًّ من الزوجين يرث صاحبَه إذا مات قبله، والزوجية التي تكون سببًا في الميراث هي التي نشأتْ عن عقدِ زواجٍ صحيح، سواء مات أحدهما قبل الدخول أم بعده؛ إذِ المدار على قيام الزوجية بينهما بناء على عقد الزواج الصحيح حقيقة أو حكمًا. وقيام العقد الصحيح حقيقة بأن كان قائمًا بينهما، فهما زوجان بالفعل، وتُوُفي أحدهما، فإنَّ الباقي منهما يرث في المتوفَّى، وقيام العقد الصحيح حكمًا إذا طلقها رجعيًّا، ثم مات أحدهما قبل انقضاء العِدَّة، فإنَّ الباقي منهما على قيد الحياة يرث المتوفَّى، إذا ما توافرت شروط الميراث وانتفتْ موانعه. رابعًا: حرمة المصاهرة: سبق أن تكلمنا بالتفصيل عن المحرَّمات من النساء نسبًا ورضاعًا وصهرًا. ولعل حرمة المصاهرة أثرٌ من آثار عقد الزواج، وليس حقًّا مشتركًا بين الزوجين، اللهم إلاَّ إذا قلنا: إنَّ حرمة المصاهرة توجب احترامًا وتوقيرًا، وتورث صلةً ومودة بين أقارب الزوجين؛ مما يعود بالخير عليهما، وعلى الأسرتين بعد ذلك بطريق التبع. والأدق أنْ يقال: إنَّ حرمةَ المصاهرة هي من الحقوق المشتركة بين حقوق الله - تعالى - وحقوق العباد، ولكن حق الله - عزَّ وجلَّ - غالبٌ فيها؛ حيث لا يَجوز لأحدٍ من العباد أنْ يتدخل فيها بإرادته، فهي أحكام الله الواجبة الاتِّباع، ومن ناحية أخرى فإنَّ هذه الأحكام تعود بالنفع على العباد على النحو الذي بيَّنا، وهذا الجانب الذي للعباد هو أيضًا مشترك بين الزوجين والأسرتين. وبهذا نكون قد انتهينا من دراسة القسم الأول بعونٍ وتوفيق من الله رب العالمين. القسم الثاني في إنهاء الزواج ﴿ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: 19] صدق الله العظيم ﴿ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: 130] صدق الله العظيم ((أبغض الحلال إلى الله - عزَّ وجلَّ - الطلاق)) صدق رسول الله تمهيد: ينتهي عقد الزواج بالوفاة، فإذا ما توفي أحد الزوجين، انتهى بينهما في هذه الحياة الدنيا، كما ينتهي عقد الزواج بالطلاق والتطليق؛ حيث يتفرق كلٌّ من الزوجين إلى حال سبيله، وينتهي عقد الزواج أيضًا بالفسخ، أمَّا الوفاة، فهي أن يستوفي الإنسان الزمن المحدد له في هذه الدُّنيا، فإذا ما انتهى الأجل المحتوم، وحل الوقت المعلوم، انتقل الإنسان إلى ربِّه الذي خلقه وسوَّاه، فيُحاسبه على ما جنتْ يداه، إنْ خيرًا فخير، وإن شرًّا فشرٌّ، والله يغفر لمن يشاء ما سوى الشرك والكفر، ويُحب التوابين ويحب المتطهرين. على أن انتهاء عقد الزواج بالوفاة إنَّما هو انتهاء للحياة بينهما في هذه الدنيا، وأمَّا الآخرة فأمرها إلى الله، فقد تكون معه زوجته وقد لا تكون، حسب إيمان كل نفس وعملها، وأثر انتهاء الزواج بالوفاة يتمثَّل في وجوب العدة على المرأة[104]، إنْ كان المتوفى هو الزوج، وفي تقسيم تركة المتوفى وإعطاء الباقي منهما على قيد الحياة نصيبَه من هذه التركة. وأما الفسخ: فهو عبارة عن نقض عقد الزواج؛ لسبب من الأسباب التي توجب حَلَّ الرابطة الزوجية. وهذا النقض قد يكون رفعًا لعقد الزواج لسببٍ من أسبابه، فيعد كأنْ لم يكن، ومثَّل الفقهاء لهذه الحالة بخيار البلوغ أو خيار الإفاقة، وقد سبق أن أشرنا إليهما في القسم الأول من دراستنا. وقد يكون الفسخُ من لحظة السبب الموجِب له، وذلك كما إذا ارتدَّت المرأةُ عن الإسلام - والعياذ بالله - حيث يفسخ العقد بمجرد الارتداد، ما لم تتُب في فترة الاستتابة، وهي ثلاثة أيام، وإلاَّ وجبت عليها العقوبة. وأمَّا الطلاقُ، فهو مرتبط بإرادة الرجل، وله شروطُه وضوابطه، وأقسامه وأحكامه. وأمَّا التطليق فهو التفريقُ بين الرجل والمرأة بحكم القاضي؛ بناءً على أسباب تستند إليها المرأة في طلب التطليق، وأدلةٍ يقتنع بها القاضي حتى يحكم به. الطلاق والفسخ: وبالجملة فإنَّ التفريقَ بين الزوجين قد يكون طلاقًا، وقد يكون فسخًا، وأثر هذا التقسيم يظهر في النتائج الآتية: أولاً: التفريق الذي هو طلاق، يُحسب من عدد التطليقات التي يَملكها الزوج في هذه العصمة، وأمَّا الفسخ فلا يحسب من عدد التطليقات. وبيان ذلك: أنَّ الرجل يَملك بعقد الزواج عصمة كاملة بثلاثِ تطليقات، فإذا استنفدها انتهتْ عصمةُ الزواج من يده بالنسبة لهذه المرأة؛ بحيث تصبح تلك المرأة أجنبية عنه، فلا تَحل له إلا بعد أن تتزوج من رجلٍ آخر زواجًا حقيقيًّا، ويطلقها طلاقًا معتادًا، أو يموت عنها، فإنَّها حينئذٍ تحل للزوج الأول بعصمة جديدة. وبهذا وضحت الفكرة تمامًا، فإذا ما طلق الرجلُ زوجته طلقة واحدة، فإنَّ هذه الطلقة تحتسب من ثلاث التطليقات التي يَملكها الزوج، ومِنْ ثَمَّ لا يكون له إلاَّ تطليقتان. أما لو كان التفريق بينه وبين زوجته فسخًا، فإنَّ الفسخ لا يحسب من عدد التطليقات التي يَملكها الزوج؛ لأن الفسخ ليس طلاقًا بإرادة الزوج، وإنَّما هو نقض لعقد الزواج الذي ثبت أنَّ شروط انعقاده لم تكن صحيحة، أو أنه صارت كذلك غير صحيحة، فوجب التفريقُ بين الزوجين لهذا السبب، فيفسخ العقد. وعلى ذلك، لو أن سبب الفسخ قد زال، وتوافرت شروطُ إبرام عقد الزواج مرة أخرى، فأبرم بينهما عقد زواج صحيح بعد ذلك، فإنَّ الحياةَ الزوجية تعود بينهما بعصمة جديدة كاملة غير منقوصة؛ حيث لم ينقص الفسخ منها شيئًا؛ لأن الفسخ لا يحسب كما هو ظاهر. ثانيًا: التفريق الذي هو طلاق، إذا تم قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة، يوجب نصف الصداق - كما سبق أن بينا ذلك تفصيلاً - أما الفسخُ قبل الدُّخول أو قبل الخلوة الصحيحة، فلا يترتب عليه هذا الأثر المالي؛ لأنَّ الفسخ نقض للعقد، فيصبح العقد كأن لم يكن، وحيث لم يحصل دخولٌ ولا خلوة صحيحة، فإنَّ العقد لا يزال عقدًا مجردًا، فإذا ما فُسخ هذا العقد صار كأن لم يكن، فلا أثر له؛ حيث نقض من أساسه. ......... 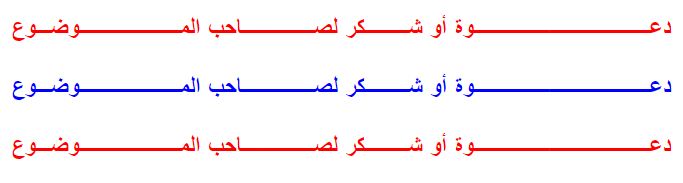  الموضوع الأصلي : حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: houdib69 
   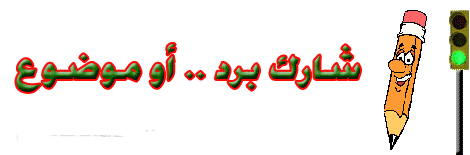
| ||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
 الثلاثاء 10 نوفمبر - 14:31 الثلاثاء 10 نوفمبر - 14:31 | المشاركة رقم: # | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  موضوع: رد: حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي موضوع: رد: حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي  حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي ضابط التفرقة بين الطلاق والفسخ: والتفريق بين الزوجين يكون طلاقًا إذا كان بإرادة الزوج، سواء قام هو مباشرة أم أناب غيره في القيام به، أم قام به القاضي نيابة عنه، وهو التطليق، ويدخل في ذلك الخلع والإيلا ؛ لأنَّهما بإرادة الزوج، كما سيأتي بيانهما بالتفصيل، وعلى خلافٍ في الرأي حول بعض الجزئيات، كما يعد طلاقًا ذلك الذي تُوقعه المرأة بناء على تفويض من الزوج. ويكون التفريقُ فسخًا إذا كان بسببٍ مقترنٍ بالعقد، يترتب عليه فسادُ العقد أو عدم لزومه، سواء كان هذا السبب من جانب الزوج أم من جانب الزوجة، كما يعد فسخًا كل تفريق بسببٍ طارئ يوجب حرمة المصاهرة بين الزوجين، سواء كان ذلك السبب من ناحية الزوج أم من ناحية الزوجة. وأخيرًا، فإنَّ التفريقَ بين الزوجين يعدُّ فسخًا إذا كان من جهة الزوجة بلا تفويض من الزوج، كما إذا ارتدتْ عن الإسلام، أو إذا أسلم زوجها وهي غير كتابية، وامتنعتْ عن الدخول في الإسلام، أو امتنعت عن اعتناق دين سماوي، هذا ما اتَّفق عليه فقهاء المذهب الحنفي. وعلى ذلك؛ فالفسخ نقض للعقد، وقد سبق لنا أنْ أشرنا إلى بعض الحالات التي تعين فسخ العقد ابتداء أو انتهاء؛ ابتداء كما إذا كانت نشأةُ العقد غيرَ صحيحة من أول الأمر، وانتهاء كما إذا ارتدت الزوجة عن الإسلام، فيصبح العقد غير صحيح من وقت الردة، فيتعين الفسخ. وبما أن الفسخ نقض للعقد، وبما أننا أشرنا فيما سبق إلى كثير من هذه الحالات؛ فإنَّنا نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بالفسخ. ويبقى أمامنا الطلاق الذي هو بإرادة الزوج وعبارته، والتطليق الذي هو بحكم القاضي، وهنالك حالات أخرى مُشابهة للطلاق والتطليق، وأيضًا فإنَّ هنالك بعضَ حالات لها أحكام مشابهة أو مكملة لحالات الطلاق والتطليق. وعلى ذلك، نتكلم في هذا القسم عن الطلاق والتطليق، ثم نتناول بعد ذلك الحالات المشابهة والأحكام المكملة. وهكذا، فإنَّ بَحثنا في هذا القسم سيكون على الوجه الآتي: الباب الأول: في الطلاق والتطليق. الباب الثاني: في الحالات المشابهة والأحكام المكملة. الباب الأول: في الطلاق والتطليق: سبق أنْ أشرنا إلى أنَّ الطلاق مرجعُه إلى إرادة الرجل، ولذلك أسبابٌ وحِكَم تشريعية نتكلم عنها في موضعها، كما أشرنا إلى أنَّ التطليق هو التفريق بين الزوجين بناء على حكم قضائي. وعلى ذلك فإنَّنا نقسم هذا الباب إلى الفصلين الآتيين: الفصل الأول: في أحكام الطلاق. الفصل الثاني: في أحكام التطليق. الفصل الأول:في أحكام الطلاق: البحث في أحكام الطلاق يستلزم بيانَ معناه لغةً وشرعًا، ثم الحكمة من تشريعه، وبيان صاحب الحقِّ فيه، وحكمة ذلك أيضًا، كما يستلزم الكلام عن الشروط الواجبِ توافرُها فيه، ولا ننسى أهمية الكلام عن الحكم الشرعي للطلاق. ومن ناحية أخرى، فإنَّ هذا البحث يحتم علينا أنْ نتكلم عن صيغة الطلاق، وأقسامه، مع بيان حكم كل قسم. نتناول ذلك كله في المباحث الثلاثة الآتية: المبحث الأول: معنى الطلاق وحكمته. المبحث الثاني: حكم الطلاق وشروطه. المبحث الثالث: صيغة الطلاق وأقسامه. المبحث الأول: في معنى الطلاق وحكمته: 1 - معنى الطلاق لغة. 2 - معنى الطلاق شرعًا. 3 - الحكمة من تشريع الطلاق. 4 - صاحب الحق في الطلاق. 5 - الحكمة من كونه بيد الرجل. معنى الطلاق: يقصد بكلمة طلاق في اللغة العربية: المفارقة، وترْك الشيء إلى حال سبيله. فأصلُ تركيب هذه الكلمة يدُلُّ على الحل والانحلال، يقال: أُطْلِق الأسيرُ إذا أُخْلِي سبيلُه وانفكَّ إساره، فالطلاق لغةً: حل الوَثاق، مشتق من الإطلاق، وهو الإرسال والتَّرك، يقال: فلان طلق اليد بالخير؛ أي: كثير العطاء والبذل. وفقهاء الشريعة لم يذهبوا بعيدًا عن هذا المعنى؛ حيث يُعرف الطلاقُ في اصطلاحهم بأنه: حل الرابطة الزوجية الصحيحة من جانب الزوج بلفظٍ مخصوص أو ما يقوم مقامه في الحال أو في المآل. فالزوجية غير الصحيحة لا يقال في حلها: إنَّها طلاق؛ بل مجرد تفريق بين رجل وامرأة اجتمعا في ظل عقد زواج غير صحيح، ففي مثل هذه الحالة يقال: تفريقٌ بين الزوجين؛ لبطلان العقد أو لفساده؛ حيث لم يوجد عقد مطلقًا في حالة البُطلان، أو وجدت له صورة لا تقرها الشريعة في حالة الفساد، وقد رأينا أنَّ كلاًّ منهما محرَّم شرعًا. فحلُّ الرباط الزَّوجي المبنيِّ على عقد زواج صحيح هو الذي يُسمى طلاقًا، متى تَم من جانب الرجل، وتم بألفاظه المخصوصة. أمَّا كونه من جانب الرجل، فذلك ما سوف نبحثه ونبين حكمته التشريعية بعد قليل. فإذا كان حل الرابطة الزوجية ليس من الرجل، ولكن بحكم القاضي، فإنَّ هذا يسمى تطليقًا، لا طلاقًا. وأمَّا الألفاظ التي يتم بها الطلاق، فهي الصيغُ المحددة لذلك شرعًا، والتي سوف نبحثُها تفصيلاً فيما بعد، وهي قد تكون صريحة في الطَّلاق وقد تكون غير صريحة فيه، فالعبارة غير الصريحة يُمكن أن تقوم مقام العبارة الصريحة - كما سيأتي. على أنَّ العبارة قد تدُلُّ على الطلاق في الحال، وهو ما يُسمى بالطلاق المنجز، وقد تدل عليه في المستقبل، وهو ما يسمى بالطلاق المضاف. الحكمة من تشريع الطلاق: أخرج أبو داود وابن ماجه عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أبغض الحلال إلى الله - عزَّ وجلَّ - الطلاق))، وفي رواية لأبي داود أيضًا، قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ما أحلَّ الله شيئًا أبغض إليه من الطلاق)). فالطلاق إذًا جعله الله بمثابة علاج مرِّ المذاق، وهو بالنسبة لحياة زوجية ثبت فشلُها هو العلاج الوحيد، بمنزله الجراحة التي لا بُدَّ منها؛ حفاظًا على سلامة الجسد. "إنَّ فرصة الإنسان في الحياة واحدة، فلماذا تجعلونها عذابًا مقيمًا لزوجين تبيَّن أنَّ الوفاق بينهما مستحيل، وأن حياتهما معًا إهدار لحياتيهما لا محالة؟ إنَّ التطبيق العلمي أثبت ذلك، وصارت أممُ الغرب المسيحية تُجيز الطلاق في قانونها بواسطة المحاكم، وذهب بعضها إلى التوسُّع في أسباب الطلاق حتى كأنَّها مهزلة شكلية". ولعله لم يغبْ عن الأذهان ما حدث في إيطاليا المسيحية؛ حيث صدر قانون الطلاق بناء على استفتاء شعبي أُجري منذ بضع سنوات. ولقد بلغ من تهافُت الشعب المسيحي هنالك أنْ بلغ عدد طلبات الطلاق التي قُدمت إلى الجهات الرسمية الإيطالية، ما يزيد على ثلاثة أرباع المليون في أول يوم صار فيه قانون الطلاق نافذًا؛ مما جعل كلَّ باحث منصف يقف مندهشًا أمام روعة الأحكام الإسلامية والتشريع الإسلامي، وصدق الله العظيم إذ يقول: ﴿ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: 130]. ومع ذلك، فليس الأمر مفتوحًا على مصراعيه؛ بل لا بُدَّ من قيود وحدودٍ وضوابط؛ لأنَّ الله - تعالى - ما أحل شيئًا أبغض إليه من الطلاق، ولم يشرعه إلاَّ علاجًا، ومن السموم الناقعات دواء. فعلى مَن ينظرون إلى أن الإسلام رخص في الطلاق ترخيصًا في أضيق الحدود، أنْ ينظروا قبل كل شيء إلى أنَّ الإسلام هو الذي رسم الطريقَ الصحيح إلى الحياة الزَّوجية المستقرة المطمئنة، وأرشد إلى الوسائل الموصلة إلى هذا الاستقرار، وحَثَّ عليها في أكثرَ من نص "فمن حُسنِ اختيار الزوجة: ((فاظفر بذات الدين، تربتْ يداك))، إلى تحذيرٍ من الانخداع بالجمال القبيح: ((إياكم وخضراء الدمن))، إلى حُسن المعاشرة والتسامح في المعاملة: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: 19]، إلى نَهي عن أسباب المضارة: ﴿ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ﴾ [البقرة: 231]، إلى التنبيه إلى أن مجرد الكراهية الطارئة لا يكفي في الإقدام على المفارقة: ﴿ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: 19]، وهذا في الواقع تشكيك في الشعور بالكراهة للزوجة، وفي هذا يقول رسول - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا يَفْرَكُ مؤمن مؤمنة، إنْ كره منها خُلقًا، رضي منها آخر))، ويقول عمر: لمن أراد أن يطلق امرأته لأنه لا يُحبها: ويحك أوَلم تُبْنَ البيوت إلاَّ بالحب؟ فأين الرعاية وأين التذمُّم؟ يريد أين ما عليك من واجب الرعاية وقد جعلك الله قوامًا على الزوجة والأسرة؟ وأين الترفُّع عن ارتكاب ما يتنافى مع الكرامة الإنسانية؟ وحتى إنْ بدر النِّزاع بين الزوجين، فإنَّ الإسلام يوجِّه إلى الإصلاح: ﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ [النساء: 128]، إلى جانب حق التأديب الذي أعطاه الله للزوجِ بِحدوده وقيوده، فإذا عَجَزَا عن الإصلاح أو لم يُفِد التأديب، انتقل الإصلاحُ إلى الأهل على مستوى الجماعة: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾ [النساء: 35]، فإذا لم ينفع التأديب، ولم يُؤدِّ الإصلاح إلى نتيجة، واستحكم النِّزاع، واتَّسعت شقة الخلاف، فليس من المصلحة في شيء بقاءُ تلك الزوجية المضطربة، ويتعيَّن فصم عُراها؛ ليستأنف كلٌّ منهما حياة زوجية أخرى تؤتي ثمارها: ﴿ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: 130]، فكان الطلاقُ علاجًا لما استعصى من أمراضِ الزوجيَّة، فهو لم يشرع إلاَّ للعلاج؛ لذا كان وضعه في غير موضعه بغيضًا إلى الله، يشير إلى ذلك حديثُ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أبغض الحلال إلى الله الطلاق)). ومَن أنعم النظرَ في طريقة تشريعه والكيفية التي رسَمها الشارع لإيقاعه، لا يُداخله شكٌّ في أنه سبيلٌ من سُبُل العلاج، يُعطَى في وقت معين بطريقة خاصة". وهكذا رخص الله في الطلاق في تلك الحالات التي يَستعصي فيها التوافُق، ويستحيل معها دوام العشرة بالمعروف؛ بحيث لا يتمكن كلٌّ من الزوجين من إقامة حدود الله، فهو إذًا بمنزلة الجراحة الواجبة للعضو الفاسد؛ حتى لا يستشري الفساد، فيهلك الروح والجسد. وقد يعترض البعض على ذلك بمصلحة الأولاد، وهو اعتبار كبير لا شك فيه، دعا إليه الإسلام ورغَّب فيه، وألقى على عاتق الوالدين عِبْء التربية الحسنة والتنشئة الكريمة، ولكن إذا استحالتْ هذه التربية الحسنة، وصارت التنشئة كريهة بالنِّزاع والشقاق، فخيرٌ للأولاد ألاَّ ينشؤوا في هذا الجو المكفهر، الذي ملأ نفوسَهم بغضًا، وكراهة، وحقدًا، وبعدًا عن حدود الله - عزَّ وجلَّ - وكما هو خيرٌ للأولاد، فهو كذلك خير للزوجين وللمجتمع، وصدق الله العظيم إذ يقول: ﴿ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: 130]. صاحب الحق في الطلاق: إذا تأملتَ النصوصَ القرآنية الواردة في الطلاق، تَجدها تخاطب الرِّجال، الأمر الذي يُفيد أنَّ الطلاق حقٌّ للرجل؛ يقول الله - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ [الطلاق: 1]، ويقول - سبحانه وتعالى -: ﴿ لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ * وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ [البقرة: 236 - 237]، ويقول - جل شأنه -: ﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ﴾ [النساء: 20]. وهكذا فإنَّ نصوصَ القرآن الكريم تفيدُ بما لا يدَع مجالاً للشك أنَّ الطلاقَ حق للرجل، وهو بحدوده وقيوده مُرتبط بإرادة الرجل: ﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ ﴾ [النساء: 20] فالمخاطبون هم الرجال، والذين يدفعون المهور هم الرجال. وهذا ما عليه عمل الصحابة أمام رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقد كان الرجال على مرأى ومَسمع من النبي - عليه الصلاة والسلام - يطلقون النساء في الحدود المشروعة دون اعتراض من النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم. وهذا تأكيد عملي وتطبيقٌ لنصوص القرآن الكريم، وسنة عملية مُتواترة منقولة بالإجماع المتواتر، الذي لا مَجال فيه لشكٍّ أو تردُّد، وقد استمر عمل الأمَّة على هذا مئات السنين أربعةَ عشر قرنًا من الزمن أو تزيد. ولقد بلغ من حرص النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - على تأكيد هذا الحق للرجل وحدَه دون سواه، أنْ أزالَ اللَّبس حتى عن الحالة التي كانت سائدة في الجاهلية - وهي مثار لبس بالنسبة للطلاق - تلك حالة الرجل الذي كان يزوج عبدَه بأمتِه، فهو على التحقيق مالكٌ للعبد وللأمَة، هذه الحالة الفريدة ربَّما يثور في ذهن مالك الرقيق أنَّه يَملك طلاقهما كما ملك زواجهما، فنص النبي - عليه الصلاة والسلام - على منع ذلك، وبيَّن أن الطلاق حتى في هذه الحالة لا يكون إلاَّ من الزوج وإنْ كان عبدًا. الحكمة من جعل الطلاق بيد الرجل: ثَبَت مما تقدم أن الطلاق بيد الرجل، والحكمة من ذلك أنَّ الرجل دون سواه هو الذي يقدِّر ظروف الطلاق وأسبابه، في رويَّة وتؤدة واستقرارٍ فكري كامل، فالمسؤولية كلها عليه، وآثار الطلاق من أعباء، ونفقة، ومتعة، وما يلزم الأولاد، ثم فوق ذلك أعباء أخرى في زواج جديد ومسؤوليات جسام، فبالنَّظر إلى أن الرجل هو المسؤول عن كلِّ ذلك، فلا يعقل أن يكون الطلاق بيد المرأة التي لا رَوِية عندها، وخاصة في ظروف النِّزاع والشقاق، فهي أعجز من أن تواجه مثل هذه المواقف الحاسمة. فلو جُعل الطلاق بيد المرأة لاضطربت الحياةُ الزوجية، ولما استقرَّ لها قرار؛ لسرعة تأثُّرها وانفعالها واندفاعها، وليس هنالك ما يحملها على التروي والأناة؛ حيث لا تغرم شيئًا. "وقد يقول قائل: وما ذنبُ المرأة تُهدَّد حياتها وأمنها واستقرارها، بسبب كلمة تخرج من فم رجلٍ عابث؟ والجواب: أنَّنا نواجه واقعًا في حياة البشر، فكيف يكون العلاج إنْ لم نأخذ بهذا العلاج؟ أتراه يكون بأن نُرغم مثل هذا الرجل على معاشرة زوجة لا يَحترم علاقته بها ولا يوقِّرها؟ فنقول له مثلاً: إنَّنا لا نعتمد طلاقك ولا نعترف به ولا نقرُّه، فهذه امرأتك على ذمتك، فهيا أمسكْها! كلاَّ، إنَّ في هذا من المهانة للزوجة ما فيه، وفيه من المهانة للعلاقة الزوجية ما لا يرضاه الإسلام، الذي يحترم المرأة، ويحترم العلاقة الزوجية، ويرفعها إلى درجة العبادة لله". ولا يعقل أن يكون الطلاق بيد القاضي؛ لأن ذلك ضد مصلحة المرأة على خط مستقيم؛ إذ كيف ترفع إلى القضاء أسرارَ الحياة الزوجية، وتكون فكرًا مشاعًا ومدونًا في محاضر الجلسات، يقرؤها الجميع، ويَطلع عليها الجميع؟ وإذا رأى الرجل أنَّ القاضي قد لا يستجيب لدعواه، فإنَّه يختلق الأسباب والمبرِّرات، وما أسهل عليه أن يَدَّعي على المرأة بما يقدح في شرفها ويحطُّ من قدرها، ويخدش كرامتها. وأيُّ فائدة للمرأة في حياة زوجية مع رجلٍ لا يريد البقاء معها؟ ألاَ إنَّ إبقاءها معه على هذا النحو إشقاء لها، ومهانة ما بعدها مهانة. ولكن لماذا لا يكون حقًّا مشتركًا؟ فكما أنَّ الزواج تم بتوافق الطرفين وتراضيهما، فلِمَ لا يكون الطلاق كذلك؟ والجواب: إنَّ الطلاق شُرع حلاًّ لمشكلة قد استعصى علاجها، فهو دواء لداءٍ عضال، ولا يعقل أن يكون ذلك متوقِّفًا على إرادة الطرفين؛ حيثُ لن يتم حل أبدًا، "فلو جعل أمر الطلاق إليهما معًا، لَمَا وصلا إلى اتِّفاق غالبًا؛ لأنَّ أحدهما يريد الفراق، والآخر لا يريده، فيعمل على الكيد والتعنُّت، فتصبح الحياة جحيمًا لا يطاق"، "على أن موقف الرجل سيكون في غاية السوء إذا عاندتْه المرأة، وأضاعت أمواله، ولم تحافظْ على بيته وشرفه، خصوصًا أنَّه هو المنفق، وأنَّها تنسب إليه، وأنَّ من تُنجبه من أولادهما منتسبون إليه"، وهكذا تترتب على مثل هذا التفكير نتائجُ في غاية الخطورة، لا يُمكن قَبولها، لا بحكم العقل ولا بحكم الشرع؛ ولذلك كانت الحكمة البالغة أن جعل الطلاق بيد الرجل، لا بيدِ المرأة، ولا بحكم القاضي، ولا باتفاق الطرفين. ومع ذلك، فإنَّ الشريعة الغراء لم تهمل المرأة في هذا المجال، فليست الزوجة تحت رحمة الزوج في جميع الأحوال إمساكًا وتسريحًا؛ ذلك أنَّ الله - تبارك وتعالى - رب الرجال والنِّساء، وهو أرحم بعباده منهم على أنفسهم، فتح أمام المرأة أبوابًا للتخلُّص من حياة زوجية لا تُطيقها، وأوسع هذه الأبواب هو التطليق، فإذا كان الطلاق بيد الرجل، فإنَّ حق المرأة أن تطلب التطليق بحكم القاضي حينما يقتنع بالأسباب المبررة لطلبها - كما سيأتي - ومن هذه الأسباب سوء عشرته لها، وإضراره الجسيم بها، ومن هذه الأبواب أيضًا الخلع، وهو - كما سنرى - أنْ تفتدي نفسها بمال تدفعه لزوجها نظير طلاقها، وأخيرًا فإنَّ من حق المرأة أن تشترط في عقد الزواج أن يكون أمرها بيدها، فإذا ما وافق الزوجُ على ذلك في العقد، كان من حق المرأة أن تطلق نفسها. ............ 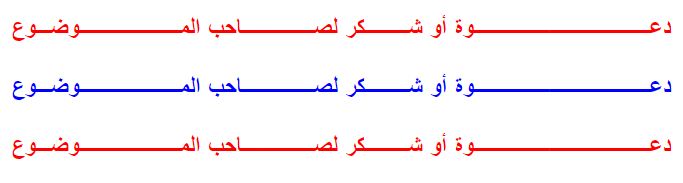  الموضوع الأصلي : حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: houdib69 
   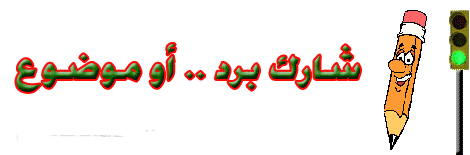
| ||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
 الثلاثاء 10 نوفمبر - 14:34 الثلاثاء 10 نوفمبر - 14:34 | المشاركة رقم: # | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  موضوع: رد: حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي موضوع: رد: حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي  حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي المبحث الثاني: في حكم الطلاق وشروط إيقاعه: نتكلم أولاً عن حكم الطلاق شرعًا، هل هو مباح أو مكروه، أو خلاف الأولى؟ وبعد بيان الحكم المذكور نتكلم عن شروط إيقاع الطلاق، نتكلم عن ذلك في الفرعين الآتيين: الفرع الأول: حكم الطلاق: 1 - حكم الطلاق بصفة عامة. 2 - آراء العلماء في ذلك. 3 - موقفنا من هذا الخلاف. 4 - حكم الطلاق حسب كل حالة على انفراد. نتكلم عن حكم الطلاق من ناحيتين: الأولى: الحكم العام للطلاق، والثانية: حكم الطلاق بالنظر إلى كل حالة على انفراد. الأولى: حكم الطلاق بصفة عامة: يُمكن تلخيصُ آراء الفقهاء في هذه المسألة، وإرجاعها إجمالاً إلى المذهبين الآتيين: المذهب الأول: خلاصته أنَّ الأصل في الطلاق هو الحظر؛ لما رُوي أن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((أبغض الحلال إلى الله الطلاق)). المذهب الثاني: وذهب فريقٌ آخر من الفقهاء إلى أنَّ الطلاق مباحٌ؛ لأن الصحابة كانوا يطلقون على عهد رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - ولم ينكر عليهم، فدَلَّ على أن الطلاق مباح، وأمَّا الحديث الذي استدل به الفريق الأول، ففي بعض طرقه ضعف من بعض الوجوه. موقفنا من هذا الخلاف: ولا شكَّ لدينا في رجحان المذهب الأول؛ لقوة سَنَده، ولما فيه من تحقيق المصلحة العامَّة، وهو ما يتَّفق مع روح الشريعة ومعقولها، وما تدْعو إليه مقاصدها العامة، التي تحرص كل الحرص على إبقاء الرابطة الزوجية بقدسيتها وأبديتها؛ تحقيقًا للغرض الذي شُرِعَ الزواجُ من أجله، وهو دوام العشرة والتعاوُن المشترك على إنشاء الأسرة، وتربية الأولاد، وتدعيم المجتمع في لبناته الأولى. أمَّا الطلاقُ، فهو خلافُ الأصل، ولا مَجالَ للتفكير فيه إلاَّ في الأحوال الاستثنائية النادرة، التي لا تتحقَّق فيها الحكمة من تشريع الزَّواج، والتي أشرنا إليها أكثرَ من مرة في أكثر من مناسبة، وكما قلنا: فإنَّ الإسلام لم يرخص في الطلاق إلاَّ لتجنب ما هو أخطر منه عندما لا تقام حدودُ الله، وتصبح الرابطة الزوجية شرًّا على أصحابها وعلى الأولاد الذين جاؤوا عن طريق هذا الزواج، فهنا فقط يرخِّص الإسلام في الطلاق؛ علاجًا لهذه الحالة الشاذة. وإذا كان في بعض روايات الحديث المشار إليه ضعفٌ من بعض الوجوه، فإنَّ هذا لا يؤثِّر مطلقًا في قوة هذا المذهب القائل بأنَّ الأصلَ في الطلاق هو الحظر؛ وذلك للأسباب الآتية: أولاً: أنَّ الأمَّة قد تلقَّتْ هذا الحديث بالقَبول على الرغم من الضَّعف في بعض طرقه، وهذا يُعطي الحديثَ قوةَ القبول، ويعوض الضعف المذكور. ثانيًا: أنَّ هذا الحديث ورد من طرُق كثيرةٍ بعضُها صحيح، كما أشرنا إلى تصحيح الحاكم له، فضلاً عن أن تعدُّد الطُّرق في رواية الحديث يفيد أن له أصلاً في الجملة. ثالثًا: وردتْ أحاديثُ أخرى صحيحة تُؤكد هذا المعنى، منها: ((أيُّما امرأة سألتْ زوجها الطلاق من غير ما بأس، فحرامٌ عليها رائحة الجنة)). رابعًا: على فرض عدم صحة ذلك الحديث، فإنَّ القواعد العامة في الفقه الإسلامي توجب القولَ بأنَّ الأصل في الطلاق هو الحظر؛ لأنَّ الأصل في الزواج هو الدَّوام والاستمرار، كما أن الطلاق ضرر لا شك فيه، خصوصًا إذا كان من دون مبرر، وقد حرَّمت الشريعة كلَّ ما يؤدي إلى ضرر أو إضرار، وفي هذا يقول النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا ضررَ ولا ضرار)). أمَّا الرأيُ المعارض، فلا حجة له سوى أنَّ بعض الصحابة - رضوان الله عليهم - كانوا يطلِّقون في عهد رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - دون إنكار، وهذا لا تقوم به حجة؛ إذ لا يعقل أن يكون الطلاقُ في الصدر الأول بلا سببٍ يدْعو إليه، أو ضرورة تُبرره؛ لأنَّ الطلاق على هذه الصورة فيه ظلم للمرأة وإضرارٌ بها دون سند. وناهيك عن الضرر فيما لو كان لهما أولاد، وحاشا لله أنْ يُنسب إلى صحابة رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - شيءٌ من هذا. وهكذا ثبت لنا أن الطلاق "تشريع استثنائي لا يلجأ إليه إلاَّ عند الحاجة، وليس أمرًا مباحًا ولا مرغوبًا فيه، يستعمله الزوج متى شاء وكيف شاء؛ لتنفير الشارع منه في أكثرَ من نص"، كما بينا ذلك بالتفصيل، والحمدُ لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ثانيًا: حكم الطلاق بالنظر إلى كل حالة على انفراد: ما قدمناه في الفقرات السابقة هو الحكم العام للطلاق؛ أي: بغضِّ النظر عن كل حالة بانفرادها؛ ذلك أنَّ للطلاق أحكامًا تختلف باختلاف أحوال الزوجين، فلو نظر إلى حياة زوجية مزعزعة، يعيش أصحابُها عيشة النَّكد والشقاء وتضيِيع حدود الله - تعالى - فإن حكم الطلاق في هذه الحالة يَختلف عن حكمه في حالة الزواج المستقر، الذي لا تشوبه إلا بعض المنغصات من بعض الوجوه. ولذلك يقول بعض العلماء: إنَّ الطلاق تعتريه الأحكامُ الخمسة؛ أي: إنَّ حكمه يختلف باختلاف كلِّ حالة على حِدَة، تبعًا للأحكام الشرعية الخمسة، التي هي الوجوب، والندب، والإباحة، والكراهة، والحرمة، وفي هذا يقول العلامة ابن قدامة الحنبلي: "الطلاق على خمسة أقسام: واجبٌ، وهو طلاق الحَكَمَيْنِ في الشِّقاق إذا رأيا ذلك، ومكروه، وهو الطلاق من غير حاجة إليه... والثالث: مباح، وهو عند الحاجة إليه؛ لسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها، والتضرر بها من غير حصول الغرض منها، والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل: الصلاة ونحوها، ولا يُمكن إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة؛ قال أحمد: لا ينبغي له إمساكُها؛ لأن فيه نقصًا لدينه، ولا يأمن إفسادها لفراشه، وإلحاقها به ولدًا ليس هو منه، ولا بأس بعَضْلها في هذه الحال؛ لتفتدي منه، ويحتمل أنَّ الطلاق في هذين الموضعين واجب، ومن الطلاق المندوب إليه الطلاقُ في حال الشقاق، وفي الحال التي تخرج المرأة إلى المخالعة لتزيل عنها الضرر، وأمَّا المحظور فالطلاق على خلاف السُّنة، وترك أمر الله - تعالى - ورسوله. والمستفاد من ذلك أنَّ حكم الطلاق حسب كل حالة بمفردها، على الوجه التالي: واجب: ومثاله طلاق الحَكَمين، فإذا اشتدَّ الشقاق بين الزوجين، ورُفع الأمر إلى القضاء، وبعث حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها للتوفيق بينهما، فثبت للحكمين أنَّ الحياة بينهما مستحيلة، وكتبا تقريرًا بذلك للقاضي، وجب الطلاق حينئذٍ، وقد يسمى في هذه الحالة تطليقًا. مندوب: ويُمثل له بما إذا فرَّطت المرأة في حقوق الله - تعالى - وعجز الزوجُ عن إجبارها، ولم تستجب لتوجيه زوجها. مباح: إذا وُجدت مبررات للطلاق، كما إذا كانت المرأة سيئة الخُلق، سيئة العشرة، وفي وجودها مع زوجها ضرر بالغ له، دون تحقيق الحكمة من الزواج. مكروه: وهو الطلاق من غير حاجة ودون مبرر، وقد سبق أنْ قلنا: إنَّ الطلاق في هذه الحالة محظور، وعلى ذلك فإن هذا القسم يندرج في النوع المحظور، وهو النوع التالي. محظور: ويُمثل له بالطلاق على خلاف السُّنة، ونضيف إليه الطلاق بلا مبرر مشروع كما سبق أنْ بينَّا. ـــــــــــــــــــــ [1] عبَّر العلماء عن ذلك في مناسبات كثيرة، منها ما قاله الإمام الغزالي: "فعليها طاعة الزوج مطلقًا في كل ما طلب منها في نفسها مما لا معصيةَ فيه"؛ ("إحياء علوم الدين"، ص 746). [2] قانتات: مطيعات، والقانتة: هي الطائعة. [3] "تفسير آيات الأحكام"، للشيخ محمد السايس، (2/97). [4] رواه الترمذي وقال: حسن غريب، ورواه ابن ماجه من حديث أم سلمة؛ ("تخريج الحافظ العراقي لأحاديث إحياء علوم الدين"، ص 746، هامش الكتاب نفسه). [5] وأول الحديث بتمامه عن عبدالله بن أبي أوفى قال: "لما قدم معاذ من الشام، سجد للنبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقال: ((ما هذا يا معاذ؟!))، قال: أتيت الشام، فوافيتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فوددت في نفسي أن أفعل ذلك لك، فقال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لغير الله، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأةُ حقَّ ربِّها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه))؛ رواه أحمد وابن ماجه؛ ("نيل الأوطار"، (6/360 - 361). والقتب للبعير أقتاب مثل سبب وأسباب، والمراد على ظهر بعير كما جاء في الرواية الأخرى. [6] على ما قرره جمهور الفقهاء. [7] "تفسير القرطبي"، ص5261. [8] المثابة: المرجع والمعاد. [9] "في ظلال القرآن"، (5/2859، 2860)، على أن خروج المرأة للعمل هو من عموم البلوى، وقد تبيحه الضرورة، وأما خروجها لغير العمل - كخروجها للاختلاط، ومزاولة الملاهي، والتسكُّع في النوادي والمجتمعات - فذلك هو الارتكاس في الحمأة الذي يردُّ البشر إلى مرتع الحيوان، ولقد كانت النساء على عهد رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يخرجن للصلاة غير ممنوعات شرعًا من هذا، ولكنه كان زمان فيه عِفَّة وفيه تقوى، وكانت المرأة تخرج للصلاة ملفعة لا يعرفها أحد، ولا يبرز من مفاتنها شيء، ومع هذا فقد كرهتْ عائشة لهن أنْ يخرجن بعد وفاة رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وفي الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: "كان نساء المؤمنين يشهدن الفجرَ مع رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - ثم يرجعن متلفِّعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس"، وفي الصحيحين أنَّها قالت: "لو أدرك رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - ما أحدث النساء، لمنعهن من المساجد، كما مُنعت نساء بني إسرائيل". فماذا أحدث النساء في حياة عائشة - رضي الله عنها؟ وماذا يمكن أن يحدثن، حتى ترى أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان مانِعَهن من الصلاة في المسجد؟ وماذا بالقياس إلى ما نراه اليوم؟ (المرجع السابق، الموضع نفسه). وروى الإمامُ الحافظ ابن كثير عن الحافظ أبي بكر البزار بسنده عن أنس - رضي الله عنهم - قال: "جئن النساء إلى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقلن: يا رسول الله، ذهب الرجال بالفضل والجهاد في سبيل الله - تعالى - فما لنا عملٌ ندرك به عملَ المجاهدين في سبيل الله؟ فقال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((من قعدتْ منكن في بيتها، فإنَّها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله - تعالى))؛ ("تفسير ابن كثير"، (3/482). [10] "إحياء علوم الدين"، ص750، وقد قال الإمام الغزالي - رحمه الله - قبل العبارة المشار إليها: "والقول الجامع في آداب المرأة من غير تطويل: أنْ تكون قاعدة في قعر بيتها ملازمة له، لا يكثر صعودها واطلاعها، قليلة الكلام لجيرانها، لا تدخل عليهم إلاَّ في حال يوجب الدخول، تحفظ بعلها في غيبته، وتطلب مسرَّته في جميع أمورها، ولا تخونه في نفسها وماله، ولا تخرج من بيتها إلاَّ بإذنه". [11] لأن الخلاف حول إظهار الوجه والكفين إنَّما هو في حالة عدم خوف الفتنة، أما عند خوف الفتنة، فيجب عليها بالإجماع ستر وجهها وكفيها. [12] لأن حق الطاعة وحق القرار في البيت، يترتب عليه أنْ تقوم بخدمة بيتها وطاعة زوجها، وإذا كان بعض العلماء قد اعتبره حقًّا رابعًا، فإننا اكتفينا بإلحاقه بهذين الحقَّين؛ فلا يتصور استقرارها في بيت الزوجية بلا عمل تقوم به. [13] ترجم الإمام البخاري لهذا الموضوع بعنوان: باب عمل المرأة في بيت زوجها، ثم ساق الرواية بسنده عن عليٍّ: أنَّ فاطمة - رضي الله عنها - أتتِ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - تشكو إليه ما تلقَى في يدها من الرحى، وبلغها أنه جاء رقيق، فلم تصادفه - أي: لم تجد النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فذكرت ذلك لعائشة، فلما جاء النبي - عليه الصلاة والسلام - أخبرته عائشة، قال علي: فجاءنا وقد أخذْنا مضاجعنا، فقال: ((على مكانكما))، فجاء فقعد بيني وبينها، فقال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ألاَ أدلكما على خير مما سألتما: إذا أخذتما مضاجعكما - أو آويتما إلى فراشكما - فسبِّحا ثلاثًا وثلاثين، واحمدا ثلاثًا وثلاثين، وكبِّرا أربعًا وثلاثين، فهو خير لكما من خادم))؛ ("صحيح البخاري"، ج3 ص 178). [14] فقد روى عن أسماء بنت أبي بكر الصديق - رضي الله عنهما - أنَّها قالت: "تزوجت الزبيرَ وما له في الأرض من مال ولا مملوك، ولا شيء غير فرسه وناضحه - ولد الفرس - فكنت أعلف فرسه، وأكفيه مؤنته، وأسوسُه، وأدق النوى لناضحه وأعلفه، وأستقي الماء، وأخرز غربه، وأعجن، وكنت أنقل النوى على رأسي من ثلثي فرسخ (حوالي ميلين) حتَّى أرسلَ إليَّ أبو بكر بجارية، فكفتني سياسة الفرس، فكأنَّما أعتقني، ولقيت رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يومًا ومعه أصحابه والنوى على رأسي، فقال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: أخ أخ؛ لينيخ ناقته ويحملني خلفه، فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذَكَرتُ الزبيرَ وغيرته، وكان من أغير الناس، فعرف رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - أني قد استحييت، فجئت الزبير، فحكيت له ما جرى، فقال: والله لَحملُكِ النوى أشدُّ عليَّ من ركوبك معه"؛ ("إحياء علوم الدين"، ص 751 - 752). [15] بأن كان وجود الخادم ميسورًا، فقد تَرِدُ المقدرة المالية والرغبة الحقيقيَّة في الاستخدام، ولكن لا يوجد الخادم. [16] القرطبي، ص 1739، والسايس ج 2 ص 96 - 97، وقوام: فعال للمبالغة، من القيام على الشيء، والاستبداد بالنظر فيه، وحفظه بالاجتهاد، فقيام الرجال على النساء هو على هذا الحد، ويعلل ذلك بسببين: ما فضَّل الله به الرجل على المرأة في العقل والرأي والعَزم والقوة؛ ولذلك خصَّ الرجال بالرسالة والنبوة والإمامة الكبرى والصغرى، وإقامة الشعائر؛ كالأذان، والإقامة، والخطبة، والجمعة، والجهاد، وجعل لهم الاستبداد بالفراق والرجعة، وإليهم الانتساب، وأباح لهم تعدُّد الزوجات، وخصهم بالشهادة في أمهات القضايا، وزيادة النصيب في الميراث، والتعصيب، وغير ذلك، وثانيهما: ما ألزم الله - تعالى - إياهم من المهر والسكن والنفقة. [17] شلبي، المرجع السابق، ص 333. [18] القرطبي، ص 1741. [19] فقد روى أحمد وأبو داود وابن ماجه أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - سأله رجل: ما حقُّ المرأة على الزوج؟ قال: ((تطعمها إذا طعمتَ، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت))؛ ("نيل الأوطار"، ج 6 ص 364). [20] فقد أمر الله نبيَّه محمدًا - صلَّى الله عليه وسلَّم - أن يهجر المشركين هجرًا جميلاً، فما بالك بالرجل مع زوجته، التي هي ألصق الناس به، وأكثرهم مخالطة له؟ ألا تستحق أن يهجرها هجرًا جميلاً؛ تأديبًا وتقويمًا؟ [21] الإيلاء: مصدر آلى بمعنى حلف، فالإيلاء لغة: هو مجرد الحلف، وأمَّا الإيلاء شرعًا: فهو الحلف من الزوج على أن يعتزل زوجته، وقد حدَّد الله أقصى مُدة لذلك بأربعة أشهر، فإمَّا أن يعود، وإمَّا أن يطلق. [22] "نيل الأوطار"، ج 6 ص 365. [23] المرجع السابق، الموضع نفسه. [24] وإن كان الله - تعالى - قد أباحه بنصِّ القرآن الكريم، فذلك لضرورة التوجيه والتقويم والتأديب. [25] وفي الحديث عن أنس - رضي الله عنه - قال: "خدمت رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - عشر سنين، فما قال لي عن شيء فعلتُه: لِمَ فعلتَه؟ وما قال لي عن شيء لم أفعله: لِمَ لم تفعله؟". [26] المرجع السابق، الموضع نفسه. [27] "إحياء علوم الدين"، ص 749. [28] رواه أبو داود والبيهقي من حديث ابن عمر، (المرجع السابق، الموضع نفسه، هامش). [29] قد يقال: إنَّ القرآن الكريم قد عبَّر عن هذا الحق المالي الثابت للمرأة بتعبير أجر وفريضة، فنقول: "كلٌّ من عند ربنا وما يعلم تأويله إلا الله - عزَّ وجلَّ - وهناك سببان آخران لاختيار كلمة صداق أشرنا إليهما في المتن. [30] على ما هو المعنى الإجمالي، وإلاَّ فعند التحقيق - كما قال القرطبي -: صدقات جمع صدقة، ويقصد بها الصداق؛ ("تفسير القرطبي"، ص 1593). [31] "سبل السلام"، ج 3 ص 147. [32] "صحيح البخاري"، ج 3 ص 156، "صحيح مسلم بشرح النووي"، ج 3 ص 582 - 578، "نيل الأوطار"، ج 6 ص 309 - 318 (كتاب الصداق)، سنن أبي داود، ج 2 ص 234 - 235 (باب الصداق)، "سبل السلام"، ج 3 ص 153. [33] "سبل السلام"، ج 3 ص 147. [34] القرطبي، ص 1594. أمَّا ما ذكره بعد ذلك في هذا الموضع، فهو ليس خلافًا في وجوب الصداق، وإنَّما في أمر آخر، وهو أن السيد إذا زوَّج عبدَه من أمَته: هل يجب في هذا الزواج صداق أو لا؟ [35] هو علقمة بن قيس أبو شبل بن مالك من بني بكر بن النخع، روى عن عمر وابن مسعود، وهو تابعي جليل اشتهر بحديث ابن مسعود وصحبته، وهو عم الأسود النخعي، توفي - رحمه الله - سنة 61 هـ. [36] الوكس: النقص. [37] الشطط: الزيادة. [38] هو أبو محمد معقل بن سنان من بني أشجع، شهد فتح مكة، ونزل الكوفة، وحديثه في أهل الكوفة. [39] أي: إنَّ بروع بنت واشق: هي امرأة من بني أشجع، ولذلك فقد وصفت في بعض الروايات بالأشجعية. [40] رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي، وحسنه جماعة، منهم البيهقي وابن مهدي وابن حزم؛ لصحة إسناده؛ "سبل السلام"، ج 3 ص 150 - 151. [41]شلبي، المرجع السابق، ص 343 - 344. [42] أخرجه أبو داود عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - وصححه الحاكم، وفيه دلالة على استحباب تخفيف المهر، وأنَّ غير الأيسر على خلاف ذلك وإن كان جائزًا؛ ("سبل السلام"، ج 3 ص 152). [43] "نيل الأوطار"، ج 6 ص 313. [44] روى أحمد بسنده عن عائشة - رضي الله عنها - أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((إنَّ أعظم النكاح أيسرُه مؤنة))؛ ("نيل الأوطار"، ج 6 ص 312). [45] أي: تحديد مقدار للصداق. [46] وقد اختلف في تفسير القنطار المذكور في الآية، فقال ابن مسعود: هو ملء مسك (أي جلد) ثور ذهبًا، وقال معاذ: ألف ومائتا أوقية ذهبًا، وقيل: سبعون ألف مثقال، وقيل: مائة رطل ذهبًا. [47] وعلى حد عبارة الشافعي - رحمه الله -: "فأقلُّ ما يجوز في المهر أقل ما يتمول الناس"، "الأم"، ج 5 ص 52، طبعة الشعب. [48] "نيل الأوطار"، ج 6 ص 312، وهذا الحديث متفق على صحته. [49] المرجع السابق، ص 314. [50] أخرجه الدار قطني موقوفًا، وفي سنده مقال؛ ("سبل السلام"، ج 3 ص 152). وهنالك أقوال أخرى لا دليلَ عليها؛ ("نيل الأوطار"، ص 6 ص 312). [51] "نيل الأوطار"، ج 6 ص 315. [52] فإنَّ في إسناده مبشر بن عبيد وحجاج بن أرطاة، وهما ضعيفان، وقد اشتهر حجاج بالتدليس، ومبشر متروك، كما قال الدارقطني وغيره، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أحمد: كان يضع الحديث؛ (المرجع السابق، ص 311، "سبل السلام"، ج 3 ص 152). [53] أي: الذي يُماثل صداق أمثالها، كما سيأتي في الفقرة التالية مباشرة. [54] شلبي، المرجع السابق، ص 350. [55] جاء في "المصباح المنير": شغر البلد شغورًا من باب قعد: إذا خلا... وشاغر الرجل الرجل شغارًا: زوج كلُّ واحد صاحبه حريمته؛ على أن يضعَ كل واحد صداقَ الأخرى ولا مهر سوى ذلك (الشين مع الغين وما يثلثهما). [56] فقد روى البخاريُّ عن عبدالله بن يوسف، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - نهى عن الشغار، والشغار أنْ يزوج الرجلُ ابنته على أنْ يزوجه الآخر ابنته، ليس بينهما صداق؛ ("صحيح البخاري"، ج 3 ص 152). [57] العقد الباطل هو الذي فَقَدَ ركنًا من أركانه، أو شرطًا من شروط انعقاده - التي بيَّناها فيما تقدَّم - مثل: زواج فاقد الأهلية، أو الزواج بمن هي محرَّمة عليه تحريمًا مؤبَّدًا لا شبهة فيه، كالعقد على إحدى مَحارمه، أو زوجة الغير، أو زواج المسلمة بغير المسلم، فهو عقد باطل لا يترتب عليه أيُّ أثر من آثار الزواج على الإطلاق، فهو محرم أبدًا، ولا وجودَ له؛ بل هو في حكم العدم، فلا يَجب فيه صداق ولا نفقة ولا طاعة، ولا يرد عليه طلاق، ولا يثبت به نسب ولا عدة ولا توارث. وإذا دخل الرجلُ بالمرأة بناء على هذا العقد، كانت المخالطة حرامًا، ويَجب عليهما الافتراق، فإن لم يفترقا، فرَّق القاضي بينهما جبرًا، وعلى كل مَن يعلم بهذا الدُّخول أن يرفع الأمر إلى القاضي؛ ليفرق بينهما؛ لأنَّ هذا الدخول زنا، وهو جريمة بَشِعة يَجب إزالتها، وعقابُ فاعليها بأشد العقوبات، وقد أجمع الفقهاء على أنه زنا، كما أجمع جمهورهم على أنَّ حد الزنا يجب تطبيقه عليهما إذا كان عاقلين عالمين بالتحريم، ولكن إذا سقط الحد لأيِّ سبب من الأسباب، فإنَّه يجب صداق المثل، ولكن لا تجب العدة؛ لأن وجوبها محافظة على الأنساب، ولا يثبت بهذا العقد نسب يحافظ عليه؛ (المرجع السابق نفسه، ص 320 - 321). [58] الزواج الفاسد هو الذي تخلف فيه شرطٌ من شروط الصحة، بعد أن توافرت أركانه وشروط انعقاده - التي بيناها فيما تقدم - مثل: الزواج بغير شهود، أو الزواج بامرأة محرَّمة عليه بسبب الرَّضاع، وهو لا يعلم بحرمتها بناء على أخبار الناس بأنه لا يوجد بينهما صلة محرمة، ثم ظهر بعد الدخول أنَّها محرمة عليه. وحكم الزواج الفاسد أنَّه زواج محرم، فلا يحل به دخول، ولا يترتب عليه في ذاته شيء من آثار الزواج، فإن حصل دخول بناء عليه، كان معصيةً يجب رفعها بالتفريق بينهما جبرًا إنْ لم يفترقا باختيارهما... غير أنَّه لا يقام على الرجل والمرأة حدُّ الزنا؛ لوجود الشبهة الدارئة للحد، وهو عقد الزواج المستكمل لأركانه وشروط انعقاده، وفي هذه الحالة عند أبي حنيفة وصاحبه يَجب للمرأة الأقل من المسمى أو صداق المثل، كما هو في المتن، وتثبت بهذا الزواج حُرمة المصاهرة، وتَجب به العدة، ويثبت به النسب... ولكن لا يوجب التوارُث بين الزوجين، كما لا يوجب نفقة ولا سُكنى ولا طلاق ولا طاعة؛ (المرجع السابق، ص 321 - 322). ../.. 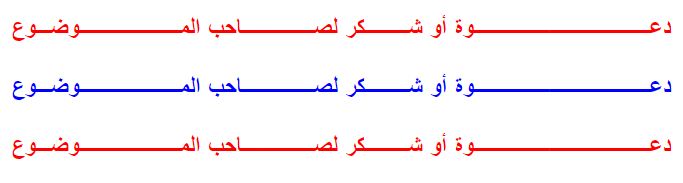  الموضوع الأصلي : حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: houdib69 
   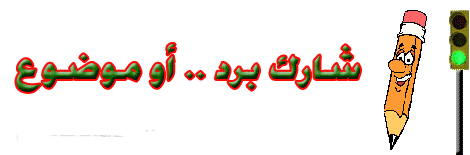
| ||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
 الثلاثاء 10 نوفمبر - 14:35 الثلاثاء 10 نوفمبر - 14:35 | المشاركة رقم: # | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  موضوع: رد: حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي موضوع: رد: حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي  حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي [59] هذا مذهب أبي حنيفة وصاحبه، وقال زفر: يَجب مهر المثل بالغًا ما بلغ؛ لأنَّ العقد ما دام فاسدًا لا يترتب عليه بذاته شيء، فتكون التسمية أيضًا فاسدة، فلا يلتفت إليها؛ إذ تكون لغوًا بحكم إبطال الشارع للعقد، ولو أوجبنا الأقل من المسمى ومهر المثل، لكان المسمى واجبًا في بعض الأحوال، وكان ذلك اعترافًا بالعقد الفاسد، وذلك لا يمكن أن يكون؛ (أبو زهرة، المرجع السابق، ص 213). [60] أبو زهرة، المرجع السابق، 200 - 201. [61] على أنَّ المانع الشرعي مردُّه أساسًا إلى ضمير الفرد ومدى تَمسُّكه بدينه؛ ولذلك فإنِّي أرى - والله أعلم - أنَّ هذه الموانع الشرعية يتعيَّن في هذه الأيام أن تكون قابلة لإثبات العكس؛ نظرًا لفساد الذِّمم، وخراب الضمائر، وبُعد الناس عن تعاليم الله؛ ولهذا السبب نفسه استحسن بعضُ الفقهاء وجوب العِدَّة في الفرقة بعد الخلوة الفاسدة بسبب المانع الشرعي، من قبيل الاحتياط. وقد تكلم الباحثون المعاصرون عن المانع الطبيعي، وهو وجود شخص ثالث، والحق أنَّ الخلوة لا تتحقق إذا كان معهما شخص آخر. [62] وصف الإحصان يترتب عليه أنَّ الزاني المحصن يعاقب بالرجم، وأما غير المحصن فيعاقب بالجلد. [63] أي: إنَّه تزوجها بنية الدَّوام والاستمرار، ولكنه طلقها بعد ذلك طلاقًا معتادًا. [64] الفار من الميراث هو الذي يطلق زوجته طلاقًا بائنًا بغرض حرمانها من الميراث؛ لأنه في مرض الموت. [65] للتوسع في هذه الجزئية؛ راجع: شلبي، المرجع السابق، ص 372 - 384. [66] يلاحقها باستجاشة شعور التقوى، ويلاحقها باستجاشة شعور السماحة، ويلاحقها باستجاشة شعور مراقبة الله؛ ليسود التجمُّل والفضل جوَّ هذه العلاقة، ناجحة كانت أم خائبة، ولتبقى القلوب نقيةً خالصة صافية موصولة بالله على كل حال؛ "في ظلال القرآن"، ج 1 ص 257. [67] على أن القانون المصري بما وضعه من حد أدنى لسنِّ الزوجين، قد ضيَّق كثيرًا من هذه الحالات، وقد نص مشروع القانون المرتقب على إلغاء زواج الصِّغار، ومن الناحية الفقهية، فإن استعمال هذا الحق إنَّما يكون عندما يقوم غير الأب أو الجد بتزويج الصَّغير، أو عندما يزوج الأب أو الجد المعروف بسوء التصرف. [68] قد يصادف أنْ تكون الزوجة قدمت لزوجها شيئًا في مُقابلة ما أعطاها على سبيل الهدية حسب ظنها، فإذا ما حكم باعتبار ما قدمه لها من الصداق واحتسب منه، فإنَّه يكون من حق الزوجة أن تطالبه باسترداد ما أعطتْه من هدايا؛ لأنه أثبت بموقفه أنَّه لا يستحقها؛ حيث ظهر لها أن ما اعتقدته هدية احتسب من صداقها، والحق أن هذا احتمال بعيد. [69] وأمَّا لغةً، فقد جاء في "المصباح": "نفقت الدراهم نفقًا نفدت، ويتعدَّى بالهمزة، فيقال: أنفقتها، والنفقة اسم منه، وجمعها نفقات"، (باب النون مع الفاء وما يثلثهما). [70] هذا التعريف أورده العلامة الصنعاني - رحمه الله - "سبل السلام"، ج 3 ص 218. [71] وفي مجال الدراسة التي لا تحتمل عرض كل الأحاديث الواردة في هذا الموضوع، نكتفي بذكر بعضها في المتن، والإشارة إلى مواضع بعضها الآخر في هذا الهامش، وعلى سبيل المثال: "صحيح البخاري"، ج 3 ص 177 - 179، "سنن أبي داود"، ج 2 ص 244 - 245، "سبل السلام"، ج 3 ص 218 - 226، "نيل الأوطار"، ج 7 ص 101 - 103. [72] "سبل السلام"، ج 3 ص 218 - 219. [73] "صحيح البخاري"، ج 3 ص 179. [74] "في ظلال القرآن"، ج 6 ص 603. [75] الحاشية السابقة نفسها. [76] وقد كانت تقول: "تقدر نفقة الزوجة على زوجها بحسب حالِ الزوج يُسرًا وعُسرًا، مهما كانت حالة الزوجة". [77] شلبي، "ملحق أحكام الأسرة"، ص 28. [78] أما المقاصة بين دَين النفقة وبين دَين ثابت للزوج على الزوجة من قبل، فقد منعه القانون المذكور إلاَّ فيما زاد عن حاجة المرأة الضرورية، وهو مسلك حسن أيضًا؛ لأن القاعدة الشرعية أن الضروريات مقدمة على أداء الدَّين. [79] سوف نشير إلى شروط المسكن الشرعي بعد قليل. [80] أبو زهرة، المرجع السابق، ص 273. [81] وهي التي استبدلت بالمادة [81] من القانون 25 لسنة 1920. [82] ولعله أمر غير مقصود، وكما سبق أنْ أشرنا إلى أنه ما من أحد أسهم في هذا القانون إلاَّ وهو يقصد تحقيق مصلحة الأسرة، وقد أكدت المذكرة التفسيرية هذا المعنى حينما قالت في تعليقها على النص المذكور: "كما أفصح المشروع عن الأحوال التي لا يعد فيها خروج الزوجة من دون إذن زوجها سببًا مسقطًا لنفقتها عليه، فقال: إنَّها الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع، كخروجها لتمريض أحدِ أبويها، أو تعهده أو زيارته، وإلى القاضي لطلب حقِّها، كذلك خروجها لقضاء حوائجها التي يقضي بها العُرف، كما إذا خرجت لزيارة مَحرم مريض، أو تقضي به الضرورة كإشراف المنزل على الانهدام أو الحريق، أو إذا أعسر بنفقتها، ومن ذلك الخروج للعمل المشروع إذا أذن لها الزوج بالعمل، أو عملت دون اعتراض منه، أو تزوجها عالِمًا بعملها؛ "المذكرة التفسيرية للقانون 44 لسنة 1979، ص 32"؛ (طبع الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية). [83] فالحكم المستند إلى عرف صحيح شرعًا هو حكم ثابت بحكم الشرع؛ لأنَّ الشارع هو الذي اعتبره دليلاً تثبت به الأحكام، ولذلك جاء في القواعد الفقهية: الثابت بالعُرف كالثابت بالنص، وقولهم: العادة محكَّمة. فذِكْرُ العُرف بعد حكم الشرع الشامل للشرعي منه لغوٌ، أو يتبادر منه غير الشرعي؛ لأن العطف يقتضي المغايرة كما يقول علماء اللغة، ومثل العرف في ذلك كلمة "أو عند الضرورة"؛ لأن الثابت بالضرورة ثابت بحكم الشرع؛ لأن الشارع هو الذي جعل الضرورة دليلاً شرعيًّا، وأساس ذلك قوله - تعالى -: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة: 173]، ومن هنا قرر الفقهاء قاعدتهم: "الضرورات تبيح المحظورات". وعلى ضوء هذا البيان، ظهر لنا أنَّ كلمة العُرف هنا مقحمة لا تفيد، إلاَّ إذا أريد بها غير الشرعي؛ لأن الشرعي منه داخل تحت حكم الشرع؛ حيث إنَّ كلمة (حكم) مفرد مضاف إلى الشرع، والمفرد المضاف من صيغ العموم، كما يقول علماء الأصول، فتعم كل حكم ثابت بدليل شرعي، سواء كان نصًّا أم عرفًا أم غيرهما. ولذلك نجد العلماء في تعبيراتهم لا يذكرون كلمة (ما يَجري به العرف) إلاَّ في مقابلة النص، فيقولون: ورد به نصٌّ، أو جرى به عرف، ولم نجد لهم تعبيرًا كالمذكور في المادة يذكرون فيه العرف في مقابلة حكم الشرع، فإذا كان ولا بد من ذكر العُرف في المادة، فينبغي صياغتها على الوجه التالي: "في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع معًا ورد به نص، أو جرى به عرف، أو قضت به ضرورة"، ولو صيغت كذلك لا تحتاج إلى تقييد، ولا يعترض عليها أحد؛ (شلبي، المرجع السابق، ص 56). [84] شلبي، "أحكام الأسرة"، ص 435. [85] البري، المرجع السابق، ص 185. [86] وإنَّما نبحثها عند كلامنا عن التطليق للغيبة والإعسار. [87] ولنا ملاحظات مهمَّة على مثل هذا الإجراء، الذي سوف نبينه فيما بعد. [88] وتمام النص: "طلق القاضي عليه بعد مُضي الأجل، فإنْ كان بعيدَ الغيبة لا يسهل الوصول إليه، أو كان مجهول المحل، أو كان مفقودًا، وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة، طلق القاضي عليه، وتسري أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة". [89] المادة الثانية من القانون 44 لسنة 1979. [90] شلبي، ملحق أحكام الأسرة، ص 29. [91] القرطبي، ص 1667. [92] "نيل الأوطار"، ج 6 ص 359. [93] المرجع السابق، الموضع نفسه. [94] متفق عليه؛ "صحيح البخاري"، ج 3 ص 161، "نيل الأوطار"، ج 6 ص 360. [95] "صحيح البخاري"، ج 3 ص 162. [96] الآية بتمامها هي قول الله - عزَّ وجلَّ -: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ [البقرة: 222]، وهذا الحكم يصدق على حالة النفاس أيضًا. [97] "تفسير القرطبي"، ص 1667. [98] عند كلامنا عن حق الزوج في طاعة زوجته له. [99] شلبي، "أحكام الأسرة"، ص 327. [100] راجع في هذا بالتفصيل: كتابنا "الحقوق المتعلقة بالتركة في الفقه الإسلامي"، ص 81 - 111، طبعة 1399هـ. [101] أمَّا ثبوت النسب، فهو أساس حق للولد، وهذا لا يَمنع من أنَّ لكل من الوالدين حقًّا في هذا الثبوت، وعلى أية حال، فإنَّنا سوف نتكلم عن ذلك تفصيلاً في موضعه المناسب، والله الموفِّق والمستعان. [102] أما الآخرة، فالأمر فيه إلى الله - تعالى - فقد تكون زوجة الرجل في الدُّنيا زوجة له في الآخرة، وقد لا تكون، سواء في ذلك أهل الجنة وأهل النار؛ يقول الله - تعالى - في أهل الجنة وفي زوجاتهم المؤمنات: ﴿ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ﴾[الرعد: 23]، ويقول - سبحانه - في أهل النار وزوجاتهم الظالمات: ﴿ احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ * مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ [الصافات ﴾: 22 - 23]. [103] المعلوم عند الله، والمجهول عند الإنسان. [104] كما سنبين في موضعه المناسب. [105] الحاشية السابقة نفسها. [106] أمَّا لو كان العقد قد تَمَّ الدخول بناء عليه، فإنه تثبت للمرأة بعض الحقوق المالية كما سبق أن بيَّنا تفصيلاً، ولكن لا بناءً على العقد؛ وإنَّما بسبب الدخول. [107] الخلع - كما سيأتي - أن تفتدي المرأة نفسها بدفعِ بعض الأموال لزوجها؛ حتى يتركها. [108] والإيلاء - كما سيأتي - هو الحلف على الابتعاد عن الزوجة. [109] ويمثل له عند الحنفية بالاتصال الجنسي بين أحدِ الزوجين وأحد أصول الآخر أو فروعه. [110] ولكنهم اختلفوا بعد ذلك في الأمرين الآتيين: الأمر الأول: ردَّة الزوج، أو امتناعه من الدخول في الإسلام إذا ما أسلمت زوجته، فيرى أبو يوسف أنَّ الفرقة هنا فسخ فيهما؛ لأنها من ناحية الزوجة فسخ بالاتِّفاق والسبب متَّحد، ويرى محمد أنَّه طلاق فيهما؛ لأنه يجب على الزوج الطلاق في هاتين الحالتين، فإنْ لم يفعل قام القاضي مقامه، وأوقع الطلاق بالنيابة عنه. وأمَّا أبو حنيفة، فإنَّه يعد التفريق بإباء الزوج عن الإسلام طلاقًا؛ لأنه من جانب الزوج، وأما التفريق بسب الردة فإنَّه يعد فسخًا عند أبي حنيفة؛ لأن الردة كالموت، والتفريق به لا يعد طلاقًا. الأمر الثاني: التفريقُ باللعان: يَرى أبو حنيفة ومحمد أنَّ هذا التفريق طلاقٌ بائن؛ لأنَّ الفرقة تزول بتكذيب الزوج نفسه، وأمَّا أبو يوسف فيرى أنَّ التفرقة باللعان فسخٌ؛ لأنه تفريق مؤبد، وعلى ذلك فحالات التفريق التي تعدُّ طلاقًا هي: 1 - ما يقع بلفظ الطلاق. 2 - الخلع. 3 - الإيلاء. 4 - التفريق لعيب في الزوج. 5 - التفريق باللعان عند أبي حنيفة ومحمد. 6 - التفريق بسبب امتناع الزوج عن الإسلام عند أبي حنيفة ومحمد. 7 - التفريق لعدم الإنفاق، أو للعنة، أو لسوء العشرة. وأمَّا التفريق الذي يعد فسخًا، فهو في الحالات الآتية: 1 - التفريق لعدم صحة العقد. 2 - التفريق بما يوجب حرمة المصاهرة. 3 - التفريق بخيار البلوغ والإفاقة. 4 - التفريق لعدم كفاءة الزوج، أو نقصان مهر المثل. 5 - التفريق بسبب ردَّة الزوجة أو امتناعها عن الإسلام، وبردة الزوج على الراجح في المذهب الحنفي، وبامتناع الزوج عن الإسلام عند إسلام الزوجة في مذهب أبي يوسف. [111] "لسان العرب"، الطاء مع اللام، "المصباح المنير"، باب الطاء مع اللام وما يثلثهما. [112] أشار إلى هذا المعنى اللغوي العلامة الشوكاني في "نيل الأوطار"، ج 7 ص 3. [113] ويعرف الشوكاني الطلاق في الشرع بأنَّه حل عند التزويج، ثم يبين أن هذا المعنى الشرعي موافق لبعض المعاني اللغوية لهذه الكلمة؛ ("نيل الأوطار"، ج 7 ص 3). [114] فضيلة الأستاذ الشيخ محمد مصطفى شلبي، "أحكام الأسرة"، ص 471، طبعة سنة 1391هـ. [115] وسوف نبين كل ذلك في موضعه المناسب. [116] "سنن أبي داود"، ج 2 ص 255، "نيل الأوطار"، ج 7 ص 2. [117] "سنن أبي داود"، ج 2 ص 255. [118] الدكتور نظمي لوقا، "محمد الرسالة والرسول"، ص 117. [119] قالوا: وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((المرأة الحسناء في المنبت السوء)). [120] شلبي، المرجع السابق، ص 461 - 462. [121] ولكن من ذا الذي يُلغي التداوي كراهيةً للمرارة، أو يُحرِّم الجراحات كراهيةً للآلام؟ لا بُد من الدواء ومن الجراحة ما دُمنا نعيش في صلاح كونٍ وفساد، وصواب وخطأ، وصحة ومرض، وحكمة وحماقة؛ بحيث لا عصمة للبشر، لا بُدَّ من وسيلة لتدارك الأخطاء، وإعطاء الفرصة لبني آدم، وبناء سعادتهم في الدُّنيا بإقامة أركانِ أُسرات سليمة الصَّرح، يعمرها الأمن والمودة والرَّحمة، والإسلام يضع رخصة الطلاق في موضع الدَّواء الكريه المَذَاق، أو مبضع الجرَّاح ولا زيادة، ولا يكون اللجوء إليه إلاَّ بعد استنفاد الحيلة في إصلاح ذات البَيْن... وقد يحتجُّ بمصلحة الأولاد، وتلك رتَّب الإسلام فيها أحكام النفقة وأحكام الحضانة، ثم ما من أحدٍ يقول: إنَّ تربية الأطفال في كنف أبوين متفاهمين متحابَّين أمرٌ يستوي وتربيتَهما في كنف أحدهما دون الآخر. ولكن المسألة هي أنَّه إذا امتنع التفاهم بين الأبوين، كان من الخير ألاَّ يفسد الأولاد في ذلك الجو الحاقد اللَّدود، فذلك أهون الشرَّين، وهو كذلك أهون الشرين للأبوين، وهي على كلِّ حال آفةٌ لا يُقبل عليها عاقلٌ وله عنها مندوحة... وقد لعن الرسولُ مَن يستخدمون رخصة الزواج والطلاق بغير حقِّها الإنساني والشرعي؛ قضاءً لمآربَ وضيعة، فجاء في الحديث الشريف: ((لعن اللهُ كلَّ ذواق مطلاق))، و((لعن الله الذواقين والذواقات))، و((لعن الله كل مزواج مطلاق))، ولحكمةٍ واضحة جعل الطلاق على ثلاث مراحل؛ حتَّى يكون هناك موضع للمراجعة قبل أن تقع الواقعة، فإنَّ سلطان الغضب غشوم؛ (د: نظمي لوقا، المرجع السابق، ص 118 - 120). وفي موضوع آخر يقول هذا الباحث النصراني: "والحقُّ أنه يعسر جدًّا تصوُّر زواج بغير الطلاق بصورة من الصور، فالزواج نظام جُعِل لإسعاد الناس، وصلاح أمور حياتهم، ولم يجعل الناس ليكونوا عبيدًا أو ضحايا للزواج، فالزواج الذي لا تستقيم به حياة الإنسان، ويتطرق إليها العطب والعفن، وصديد الحق والسخط، فهذا ينبغي أن يبتر قبل أن يقضي على فُرصة الحياة الفذة المقدسة، كما يبتر العضو الفاسد من جسم المريض؛ حرصًا على بقاء الجسم كله، مهما كان ذلك العضو المبتور عزيزًا؛ (المرجع السابق، ص 116). [122] إلاَّ عند مخالفة شروط الطلاق أو أحكامه، كما حدث بالنسبة لعبدالله بن عمر حين طلَّق زوجته وهي حائض، فقال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - لعمر: ((مُره فليرجعها، ثم يطلقها في طُهرٍ لم يجامعها فيه)). [123] فقد روى ابن عباس - رضي الله عنهما - أنَّ رجلاً جاء إلى النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقال: يا رسول الله، سيدي زوجني أَمَتَه، وهو يريد أن يفرق بيني وبينها؟ قال: فصعد رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - المنبرَ، فقال: ((يا أيها الناس، ما بالُ أحدكم يزوجُ عبده أمَتَه، ثم يريد أن يفرق بينهما! إنَّما الطلاقُ لمن أخذ بالساق))؛ أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن. [124] شلبي، المرجع السابق، ص 473. [125] "في ظلال القرآن"، ج- ص 250. [126] فالقول بأنَّ القاضي هو الذي يصدر الطلاق؛ لأسباب محددة - مثل الزنا - قولٌ فيه وجْه غضاضة؛ لأنَّ التحاكُم في دور القضاء فيه ابتذالٌ للأعراض، حتى تغدوَ مضغة في الأفواه، وعُرضة للَّجَاجة والملاحاة.... إنَّ صون الأسرار وأسباب الفراق هنا أليق، وفيه من النخوة والبصيرة الشيءُ الكثير؛ حتى لا تُوصم المرأة بما يَعيبها ويعوق زاوجها مرة أخرى، وحتى لا يوصم بناتها أو أبناؤها بما تردَّد في قاعات المحاكم من مثالبها، وقد يصدر حكم القاضي تأسيسًا عليه... ثم كيف لنا بتحديد الأسباب التي تُجيز الطلاق بناءً على طلب الرجل؟ إنَّ الزواج صلة حميمة، وقد لا يرى الغريب في المرأة عيبًا، ولكن يَجد الزوج فيها عيبًا كبيرًا، وليس من الضَّروري أنْ يكون ذلك العيب جسيمًا، فهناك اختلافُ الطباع، مع كمال الأدب في الزوجين؛ بحيث يمتنع بينهما الامتزاج والتفاهم، أَمَا ترى إلى الماء قد يكون من أجود الماء، وإلى الزيت قد يكون من أجود الزيت، ثم لا يمكن بينهما امتزاج؛ لاختلاف المعدنين؟ كذلك الناس معادن شتى، قد يطيب كلُّ معدن منها على حِدَة، وليس ضربة لازب أن يَمتزج أيُّ معدنين منها على الوجه الذي تستقيم به حياة الزواج، وعندئذٍ يكون الافتراقُ خيرًا وأولى؛ لأنَّ كلاًّ من الزوجين قد يصلح كل الصلاح للزواج بآخر، ويَحيا حياة سعيدة، فلا عيبَ في الدواء إذًا، ولا يطعن في صلاحه أنْ تطيش به يد أو يشتط لسان، ولا يطعن على الماء أنْ يشرق الشارب، أو يغرق فيه المغتسل، ولا يطعن في النار أنَّها قد تكون حريقًا لا يُبقي ولا يذر، فالمعول كله على تقوى الله، ثم على حسن البَصَر ومُراعاة الحذر؛ (د. نظمي لوقا، المرجع السابق، ص 110). [127] شلبي، المرجع السابق، ص 474. 7 [128] مدكور، المرجع السابق، ص 216. [129] رواه أبو داود وابن ماجه عن عبدالله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما؛ ("سنن أبي داود"، ج 2 ص 254 الحديث رقم 2178)، وصححه الحاكم، ورجَّح أبو حاتم إرساله، وكذا الدارقطني والبيهقي رجَّحَا الإرسال؛ ("سبل السلام"، ج 3 ص 168)، وفي تعليق بهامش هذه الصفحة يقول المعلق ما نصه: "وأقره الذهبي وقال: إنَّه على شرط مسلم، ولكن متنه متضارب؛ لأنَّ بغض الله له منافٍ لحله". ويقول عنه الشوكاني: "أخرجه أيضًا الحاكم وصححه، ورواه أيضًا أبو داود، وفي إسناد أبي داود يحيى بنُ سليم وفيه مقال، ورواه البيهقي مرسلاً ليس فيه ابن عمر، ورجَّح أبو هاشم الإرسال، وفي إسناده عبيدالله بن الوليد حصافي وهو ضعيف، ولكنه قد تابعه معرف بن واصل، ورواه الدارقطني عن معاذ بلفظ: ((ما خلق الله شيئًا أبغض إليه من الطلاق))؛ قال الحافظ: وإسناده ضعيف ومنقطع، وأخرج ابنُ ماجه وابن حبان من حديث أبي موسى مرفوعًا: ((ما بالُ أحدكم يلعب بحدود الله يقول: قد طلقت، قد راجعت))؛ ("نيل الأوطار"، ج 7 ص 2 - 3). [130] الهامش السابق من هذه الصفحة. [131] " رواه أبو داود والترمذي والدارمي وابن ماجه وصححه الألباني. [132] لفظ ابن قدامة هنا: خمسة أضرب؛ أي: خمسة أقسام. [133] مثَّل ابن قدامة - رحمه الله - للطلاق الواجب بمثالين: الأول: هو طلاق المولي بعد التربُّص إذا أبى الفيئة، بمعنى الطلاق في الإيلاء، الذي هو حلف الزوج على الابتعاد عن زوجته لمدة أربعة أشهر، وبعد انتهاء المدة أَبَى أنْ يعود، والثاني: طلاق الحَكَمَين. [134] وعند الحنابلة في الطلاق من غير حاجة إليه روايتان: إحداهما: أنَّه مُحرم؛ لأنَّه ضرر بنفسه وبزوجته، وإعدامٌ للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه، فيكون حرامًا، كإتلاف المال، ولقول النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا ضررَ ولا ضرارَ))، والثانية: أنه مباح؛ لقول النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أبغض الحلال إلى الله الطلاق))... وإنَّما يكون مبغضًا من غير حاجة إليه، وقد سماه النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - حلالاً، ولأنَّه مزيل للنكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها، فيكون مكروهًا؛ "المغني"، ج 8 ص 234، طبعة 1348هـ، وجدير بالذكر أنَّ الرواية الثانية مَحل نظر؛ حيث سبق لنا ترجيح الرأي القائل بالتحريم؛ للأدلة القوية التي قدمناها، والله ولي التوفيق. [135] ونص عبارة ابن قدامة: "وأمَّا المحظور، فالطلاق في الحيض، أو في طهر جامعها فيه، أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه، ويُسمى طلاق البدعة..."؛ ("المغني"، ج 8 ص 235). وقريب من عبارة ابن قدامه ما عبَّر به العلامة الشوكاني من أنَّ "الطلاق يكون حرامًا ومكروهًا وواجبًا ومندوبًا وجائزًا، أمَّا الأول - أي: الحرام - ففيما إذا كان بدعيًّا، وله صور، وأمَّا الثاني - أي: المكروه - ففيما إذا وقع بغير سبب مع استقامة الحال، وأمَّا الثالث - أي: الواجب - ففي صور، منها الشِّقاق إذا رأى ذلك الحكمان، وأمَّا الرابع - أي: المندوب - ففيما إذا كانت غيرَ عفيفة، وأمَّا الخامس - أي: الجائز - فنفاه النووي، وصَوَّره غيره بما إذا كان لا يريدها، ولا تطيب نفسه أن يتحمل مُؤنَتَها من غير حُصولِ غرض الاستمتاع؛ ("نيل الأوطار"، ج 7 ص 3). ويلاحظ أنَّنا قد رجحنا القول بتحريم الطلاق إذا كان بغير سبب، خاصَّة من استقامة الحال. =========== ====== === 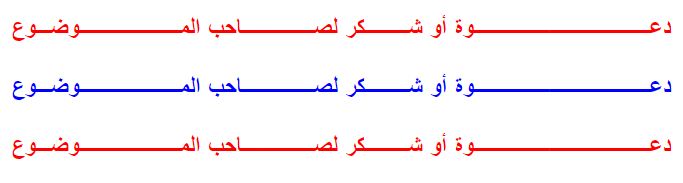  الموضوع الأصلي : حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: houdib69 
   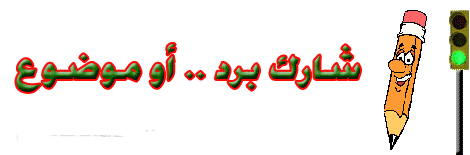
| ||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
 الثلاثاء 10 نوفمبر - 14:38 الثلاثاء 10 نوفمبر - 14:38 | المشاركة رقم: # | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  موضوع: رد: حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي موضوع: رد: حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي  حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي بارك الله فيك ننتظر منك الكثير من خلال ابداعاتك المميزة وكل التوفيق لك والتألق 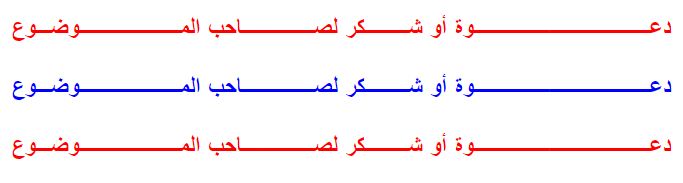  الموضوع الأصلي : حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: mohamedb 
   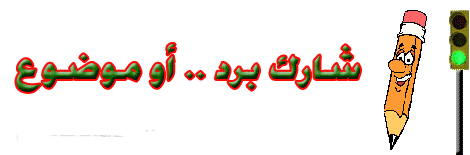
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| الكلمات الدليلية (Tags) |
| حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي , حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي , حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي , |
| الإشارات المرجعية |
| التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك |
| الــرد الســـريـع | |
|---|---|
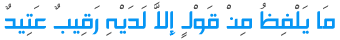 | |
آلردودآلسريعة : | |
« الموضوع السابق | الموضوع التالي »
|
اختر منتداك من هنا
| |
|
| المواضيع الأكثر نشاطاً |
| المواضيع الأكثر شعبية |
| مواضيع مماثلة |
| بحـث |